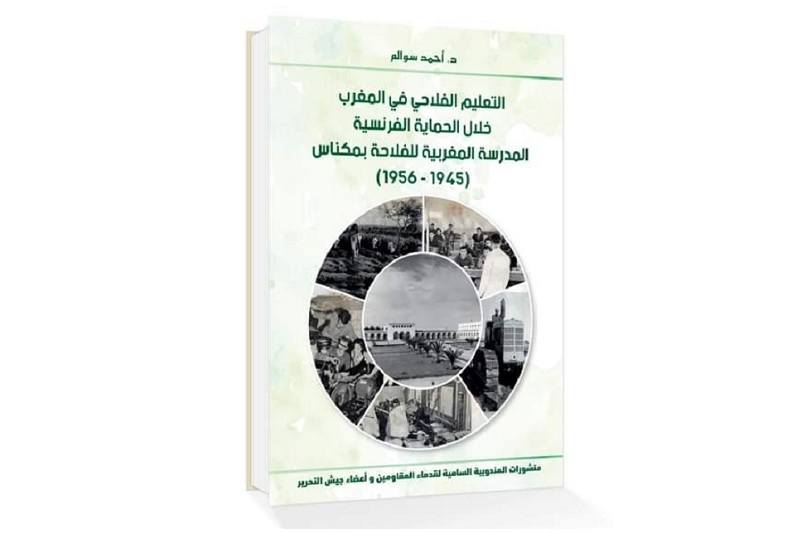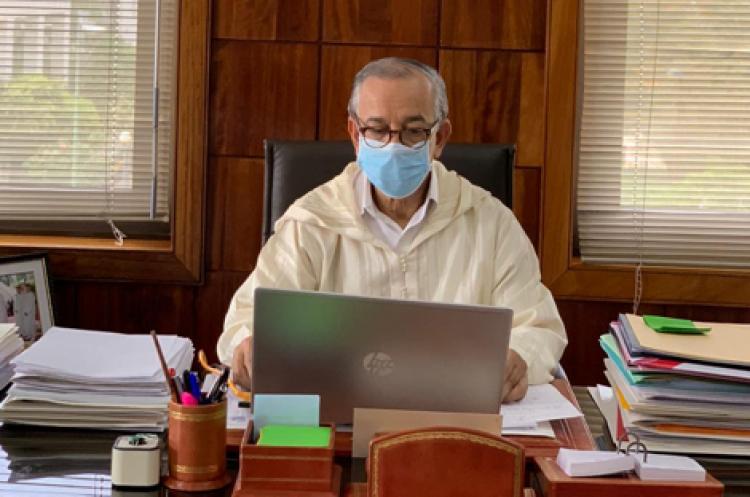مدخل إشكالي
في بروز لافت لتيارات أمازيغية منذ عقدين، استوطنت أقلام لها بعض الجرائد الإلكترونية حتى لا نقول الورقية؛ كتبت وتكتب عن قضايا تعتبرها حيوية وذات توجه “مصيري” بالنسبة لإحلال اللغة الأمازيغية مكانتها باعتبارها اللغة الأم؛ كما تلح عليه معظم هذه الأقلام؛ قبل الفتوحات الإسلامية، بل وتذهب الجرأة “العلمية” ببعضها إلى أن البيئة اللغوية التي سادت مناطق شمال إفريقيا أو بالأحرى بلاد المغرب كانت أرض خلاء من أية لغة باستثناء الأمازيغية التي كانت لسان العديد من السكان على اختلاف سلالاتهم ولهجاتهم، بمن فيهم الرومان والبيزنطيين والعرب في ما بعد.
كما يلاحظ؛ وبكثير من التعسف العلمي؛ وجود أقلام “تخصصت” في إقصاء العربية وتبخيس دورها في الموروث الثقافي الإنساني، بل؛ وبمكابرة ملحوظة؛ تتحامل عليها بذريعة أن كان لها اليد الطولى في خنق الأمازيغية وتجريدها من أسباب النمو والانتشار والتداول، والمفارقة الأكثر غرابة وجود هذه الكتابات؛ وبهذه الحمولة الإقصائية؛ باللغة العربية، يكيلون لها العداء بأداتها، وقد همّت هذه العاهة معظم التيارات والجمعيات الأمازيغية؛ بما فيها “التجمع الأمازيغي العالمي” الذي يدبج تقاريره الدورية بالعربية أو الفرنسية.
وحري بنا الإشارة إلى أن هذه الضبابية والشوفينية في تناول الأمازيغية لا يجب بحال أن تحجب عنا كتابات أمازيغية أخرى؛ على قلتها؛ رصينة تصدر؛ في مرجعياتها؛ عن رؤية شمولية تتجاوز المحلي لتنفتح على وضعيات لسنية أخرى في مجال اللغات المقارنة؛ تقف منتقدة بصورة خاصة التيفيناغية ما إن كانت تقوى على التعايش والصمود إلى جانب الفبائيات لغات أخرى أم لا.
لسنا؛ في هذه العجالة؛ نروم الوقوف عند الدوافع أو بالأحرى المرامي البعيدة التي تحرك هذه الأقلام الأمازيغية على وفرتها، ولا مناقشة المواقف حينما يختلط فيها السياسوي بالثقافي والعرقي، بل غرضنا يتحدد في محاولة استشراف البعد الثقافي الأمازيغي واتخاذه من التعليم مطية له، أو على الأرجح؛ وبالمفهوم الاقتصادي الصرف؛ ما هي القيمة المضافة لتعليم الأمازيغية؟ أم أن الكتابات تتجاوز هذه الإشكالية لتطمح لأن تصبح لغة الإدارة والتقاضي والاقتصاد؟ وهل هذا الطموح في حد ذاته مشروع ولا يشكل للنظام السياسي تحديا ومحاذير؟!
أرض الأجداد وإشكالية الهوية
غني عن البيان أن البيئة اللغوية المغربية ثرّة بعدة مكونات ألسنية بحمولتها الثقافية الضاربة في القدم، شهدت؛ على مر التاريخ؛ تعايشا وتجاورا ملتئمين حفظت لنا أوعيتها عادات وتقاليد وطقوسا؛ مازالت حتى الآن تنعت بالتقاليد المغربية “الأصيلة”، حضور الجانب الديني فيها باهت سواء تعلق الأمر بالأمازيغي أو الحساني أو العبري.. والإسباني والفرنسي أحيانا. ولم يحتفظ لنا التاريخ بكل أشكاله؛ الشفاهي منه والكتابي والوثائقي والأداتي ظهور نزعة أصولية تروم الهيمنة وادعاء ملكية أرض الأجداد إلا في التسعينيات من القرن العشرين، حينما ظهرت نزعات وميول تحت الشعور بالغبن والتشييء objectification، تبلورت في ما بعد ضمن تيار ثقافي بحْت؛ بدأ نشطاؤه بالمطالبة بتبني الأمازيغية كمكون ثقافي، لكن سرعان ما بنوا عليه مطالب أخرى بعيدة المرام. وقمين بنا؛ ونحن أمام إشكالية ضبط الهوية الأمازيغية التي تصدر عنها هذه الأقلام؛ أن نتساءل في هدوء: هل بإمكان الأمازيغي أو العربي معا أن يجزم بتسلسل أصله وانحداره من السلالة الأمازيغية أو العربية، بدءا من الجد الخامس أو الرابع..؟ هل علم الأنساب Gemealogy قادر على تحديد شجرة “أصول” هوية ما إن كانت أمازيغية صرفة أو عربية صرفة؟ علما أن لغة الأم (داخل الأسرة) لا يمكن اتخاذها معيارا في تأصيل الهوية، ولا صفة وراثية لهذا “التأصيل”، بل إن علماء الوراثة Genetists وعبر اشتغالهم بالمادة الوراثية DNA أو الحمض النووي؛ وقفوا عاجزين أمام قضايا إثبات الأبوة من نفيها تجاه مواليد لاشرعية بنسبة تفوق ٪30، وعليه فإن صعوبة تحديد سلالة الشخص الأمازيغي من العربي يفند القول بأصالة الأمازيغي أو العربي، ويترك هذا “التحديد” مشرعا على عدة فرضيات أدناها اختلاط الأنساب والتزاوج في ما بينها؛ فكم من أمازيغي يتحدر من جده العربي الرابع، وكم من عربي ذو أصل أمازيغي من جده الثالث أو الرابع، وكم من عربي أو أمازيغي تعود أصولهم إلى اختلاط الأنساب بين ما هو عربي وبين ما هو أمازيغي، وكم من أمازيغي وجد أصله في سلالة جرمانية؛ كما ذهبت إليه بعض الآراء في تحقيق الأنساب بأن بعض القبائل الريفية (شمال المغرب) تعود في أصولها إلى إثنيات آرية.
وإذا أخذنا بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014 أدركنا أن الناطقين بالأمازيغية لا تتجاوز نسبتهم ٪26،7 من سكان المغرب، وهذا يؤشر على “الأغلبية العربية” لساكنة المغرب وليست الأغلبية الأمازيغية كما تزعم هذه الأقلام، يعززه الطرح القائل بأن العربي كان عبر التاريخ “مزواجا” وجاء الإسلام ليحتفظ له بهذه “الصفة” عبر الآية القرآنية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، بينما الأمازيغي لم يعرف تعدد الزوجات إلا في ركاب الإسلام.
القيمة المضافة لتعليم الأمازيغية
جدير بالإشارة إلى أن الوضعية اللغوية في المغرب تعرف تنافرا ملحوظا في الصّواتة Phonetics والتراكيب Syntax؛ تعرفها العربية والأمازيغية والفرنسية، إلى جانب اشتقاقاتها؛ في اللسان الدارجة؛ من لهجات تربو عن العشر لا نكاد نعثر لها على جذوع نحوية مشتركة.
هذه الوضعية المعقدة يعاني منها التلميذ المغربي الديگلوسي Digloss؛ كإحدى العقبات التي تقف دون إلمامه بإحدى اللغات داخل المؤسسات التعليمية، يتعلم الأمازيغية إلى جانب العربية والفرنسية.. ليصطدم بأخرى في محيطه؛ العامية ولغة “فيسبوك” ولغات إعلامية أخرى.. لكن السؤال المطروح بإلحاح: ما هي القيمة المضافة من وراء تعلم الأمازيغية وسط هذا التراكم اللغوي؟ هل للاستئناس بها كمكون ثقافي واجب الحفاظ عليه، أم كلغة فكر وإبداع؟ أم كلغة وظيفية في المرافق الإدارية..؟
بعض الأقلام الأمازيغية المتنطعة لا ترى فيها (الأمازيغية) إلا الجانب الوظيفي، والطموح إلى واقع فعلي أمازيغي يزخر بشيكات ورسوم وعقود معاملات وتكنولوجيا وخرائط.. وبرمجيات ومواعيد إقلاع الطيران بالأمازيغية، بيد أن كثيرا من الطموحات تمسي أحلاما إذا كانت موغلة في الطوباوية utopianism، وهنا يجدر بنا رفع التساؤل: هل استحضرت هذه الأقلام؛ في طموحاتها هذه؛ البعد الزمني في تنزيل لغة ما إلى أرض الواقع؟ فعلماء اللسانيات الوظيفية والسوسيولوجيا والاقتصاد.. في جوابهم عن هذا الطرح التساؤلي؛ يشترطون وجود تراكم معرفي مادي لا يقل زمانه عن عقود، فالكاطالانية قطعت أشواطا بعيدة في الزمن والتواصل قبل أن تصبح لغة رسمية، شأنها شأن اللغات الصربية والبرتغالية… وبعض لهجات الهنود الحمر بأمريكا.
إن التنمية الاقتصادية في بلد ما؛ كما أكدته العديد من البحوث؛ تصطدم بالتعددية اللغوية الوظيفية ما إن كانت الدولة تتبنى؛ في منظومتها الإدارية؛ هذه اللغة أو تلك، ولنا في التاجر الأمازيغي (الشلح أو السوسي) أقرب مثال لهذا التوجه، حيث لا يمكنه ممارسة التجارة والمعاملات إذا لم يكن يتحدث العامية المحلية.
أقلام أمازيغية تنحو إلى التغريض
هناك أقلام لا تفتأ عن إمطار قرائها بكتابات؛ عنيفة في خطابها وشوفينية في توجهاتها؛ يبلغ بها الطموح والتيه و الاستمناء الفكري (Cognitive masturbation) مداه في رؤية مغرب (أمازيغي) “مستقل” بإدارته وإعلامه واقتصاده وسياسته.. ولا تعير قليل اهتمام للمكونات الثقافية الأخرى، إذا لم تكن تنحي عليها باللائمة في “تقزيم الأمازيغية” وخنق حريات أصحابها!
أما هذه الكتابات التي لا تخلو من تغريض، فيجب قراءتها للتاريخ المغربي والتقاط المؤشرات الفارقة في أحداثه، منها الإشارة أولا إلى أن الشعب المغربي؛ في عمومه حاليا؛ يتميز بوعي ثقافي سياسي، هو من الهشاشة حيث يسهل اقتياده إلى المجهول، لا سيما إذا استحضرنا انغماس معظم شرائحه الاجتماعية في ثقافة الخرافة وبدعم من وسائل التواصل الاجتماعي التي كثيرا ما يبني عليها مواقفه وسلوكياته؛ حتى بات من السهولة بمكان إقناعه وحمله على اتجاه سياسي معين من خلال الترويج له عبر هذه المنصات الاجتماعية؛ ولنا أيضا في التاريخ السياسي المغربي القريب خير شاهد على انفجار ثورات بالعديد من مناطقه وبمطالب؛ تعد في جوهرها مقدّمة للانفصالية؛ كالإعفاء من أداء الرسوم والحق في تولية هذا (الحاكم المحلي) دون الآخر.. والحق في اقتسام الجبايات والمكوس.. هذا علاوة عن ثورات كانت تروم الانفصام عن السلطة المركزية، إلى جانب محاولة انقلابات عسكرية جرى وأدها في المهد، وقد كلف إخماد نيران هذه الثورات المغرب كثيرا، بيد أن هناك حدسا وطنيا يحرك الوعي الجماعي المغربي إذا هو لاحظ أو شعر بأن وحدته باتت تحت المساومة.
ونعتقد أن الحنين إلى عصر (يوبا) أو (ماسينيسا)، أو زعامة من الزعامات الأمازيغية هو ضرب من الشوفينية الموغلة في الكراهية والإقصاء؛ تقتات أحيانا كثيرة من الخطاب العرقي الفج وتحت مظلة أجندة أجنبية مدسوسة؛ ترمي إلى المس باللحمة الوطنية الموحدة.