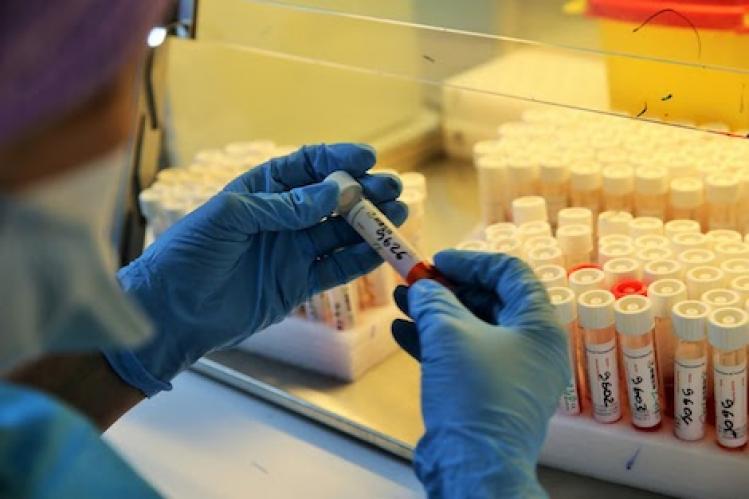فيلم إسباني مرعب يسرد وقائع مشبعة بالمعاني (بلاتفورم الذي صدر في نونبر 2020). اختار مخرج الفيلم جالدير جازتيلو وروتيا مائدة الطعام وجعلها بؤرة تجري حولها صراعات شديدة في سجن مفرط في طبقيته. هذا السجن اختزال مكثف بشع للعالم الخارجي.
في الفيلم بصمة خيال تراجيدي إسباني، لكن في الكاستنيغ وجوه بيضاء وسمراء وسوداء وصفراء. انتقى الكاستينغ وجوها من سحنات عديدة ليجعل الحفرة اختزالا للعالم.

خطط المخرج ليصور نظرية إيفان بافلوف العابرة للمجتمعات حول “مثير استجابة”. بدأ الفيلم بإعلان نظرية ثم عمل على إثباتها بالسرد بتجسيد قانون التعلم بالتجويع الذي يتحكم في البيولوجيا العصبية للفرد.. فيلم فيه سرد بنزعة كلبية تتراكم وتتدحرج فتكبر وتدمر ما تجده في مسارها.
يتم تعريض السجناء لضغط هائل. بسبب التجويع يتحكم البطن في الجهاز العصبي… تحتاج كتابة سيناريو مثل هذا معرفة عميقة بالبشر.
هنا تلتقي الكاميرا وعلم الاجتماع؛ كلاهما منشغل بمراقبة البشر. نبراتِ صوت الجياع وحركات أجسادهم أكثر تأثيرا من كل البراهين. تحدق الكاميرا في الهنا والآن وليست مصابة بداء التأمل، لذلك تناسبها المدرسة السلوكية. تنجح السيناريوهات التي تستثمر المدرسة السلوكية في شد الجمهور، كما نجحت نظرية التعلم التي بنيت على السلوكية، وكما نجحت الرواية الأمريكية بين الحربين.
تجري الأحداث في مكان مصمم خصيصا للفيلم، ولا وجود له في العالم الواقعي، لكن يدل عليه. مكان يسمى حفرة. في الحفرة لكل فرد الحق في الاختيار، والاختيار الوحيد الذي لديه هي أن ينزل تحت.
هنا يتحرك السجناء بحافز أساسي ووحيد، بسبب الجوع يصير كل جدول الأعمال وكل البرنامج هو الحصول على الطعام. ولتحقيق الهدف ليس هناك أي حاجز… الجوع يجلب الجنون والغضب ثم الموت، وهذا يسهل الاختيار بين: عليك إما أن تأكل البشر أو يأكلوك.
بمنطق إما مفترس وإما طريدة، يقنع سجين زميله في الزنزانة بأكله، والحجة منطقية، وهي أن موت واحد أقل خسارة من موتهما معا. الكانيباليزم ضرورة وليس اختيارا… مشاهدة هذا الفيلم دفعة واحدة في قاعة سينما سيسبب أذى نفسيا للمتفرج، بينما مشاهدته بطريقة متقطعة على نيتفليكس تخفف الأثر الكئيب.

الكانيباليزم ليس مرضا نفسيا كما في أفلام الأرستوقراطي دراكولا، بل ضرورة وجودية، حين تصل يد الفرد إلى الصحن، تقول طريقة الأكل كل شيء عن البشر. الأكل نادر، وحتى حين يتوفر فهو غير موزع بعدالة. يعجز الجائع عن مراقبة بطنه، الجوع يسبب الغضب، وبعد الغضب يبدأ العنف…تعرف الحفرة عنفا فوضويا ومدمرا، لكن لها اسما رومانسيا في الوثائق الرسمية، وهذا عنف ببعد سريالي.. يتجادل قاتلان، لكن أحدهما يفتخر بأنه أكثر تحضرا من الآخر لأنه يتفضل ويخبر مسبقا ضحيته كيف سيقتلها.
في السجن، الجسد هو جهاز المقاومة الأساسي لدى شخصيتين، عجوز ذو نزعة كلبية شديدة.. توفر شخصية العجوز هذه للمخرج منصة لسرد البلاهات التي نقترفها ولا نراها. وفي مواجهة العجوز سجين شاب يعلن عن تمثله للعالم بالكتاب الشهير الذي يقرؤه. الكتاب صديق السجناء، لكن الجياع لا يميزون الحروف…
سجينان واحد يحمل سكينا وآخر يحمل كتابا.. سمي الثاني النبي، والصراع بينهما على أشده.. من سينتصر في ظل عدوانية الطبيعة البشرية؟ تبين التجربة أن النبي المسلح وحده ينتصر. جاع النبي الأعزل في الفيلم فصار يأكل أوراق كتابه.
بينما يجري صراع ثنائي تتدخل أطراف أخرى، تتكرر مفاهيم الصعود والهبوط، تتم تعرية العلاقات الاجتماعية بكشف موقف من هم فوق ممن هم تحتهم، وهكذا دواليك من القمة حتى القاع. الذين فوق يبولون على الذين تحت.
ترحل المائدة بين الطبقات، كل فرد يعتقد أن العدالة هي أن يصعد هو فوق، لا يعنيه من تحته.
كيف تكون مائدة البلاد حين تكون عند حكام البلد؟ وكيف تصير عندما تنزل إلى يد الفقراء؟.. تكون أنيقة ممتلئة ثم تصير مزبلة. الفقراء يأكلون في المزابل. كل “الحثالة” في الأسفل يسمون من في الأعلى “أوغادا”. لا تغير الشتائم الواقع. يتضح أنه يحق للذين في المستويات العليا الاختيار بين أشياء كثيرة بينما المقيمون في الطبقات السفلى ينقرضون مبكرا. هذه نتيجة طبيعية للاعدالة المكان ولا عدالة الطعام. حاليا تخشى منظمة الصحة أن يتم دهس الفقراء في الزحام لنيل اللقاحات ضد فيروس كورونا. غالبا سيكون ثمن حياتهم رخيصا كما في الفيلم.

هيمنت على الثلثين الأولين من فيلم “بلاتفورم” أجواء براري “ناسيونال جيوغرافيك”، وفيها ينطلق السرد والبطل بسرعة قصوى مثل نمر، بينما يطرح الفيلم في ثلثه الأخير مشروع الانتقال من الغريزة إلى الإرادة، من الطبيعة إلى الثقافة.
في الثلث الأخير محاولة نضالية لإحلال الإرادة مكان الغريزة.. يقع التغيير حين يتحالف المضطهدون، تصرخ إحدى المناضلات: “يا من أنتم فوق، كلوا فقط على قدر حاجتكم واتركوا للآخرين نصيبهم، أتوسل إليكم”.
ولا من يصغي. الجشع يسيطر على البشر. عندما يفشل الإقناع ينجح الإكراه. إن “التغيير لا يكون أبدا عفويا”. هكذا غرق الفيلم في عنف دموي طبيعي، في سيلان لعاب الجياع، وهذا غير مشرف للبشر.
المشكل أن الطبيعة لا تملك معنى في ذاتها. يقول باروخ سبينوزا: “إنّي لا أعزو إلى الطّبيعة جمالا ولا نظاما ولا اضطرابا، فليس في وسع المرء أن يقول عن الأشياء إنّها جميلة أو قبيحة أو مضطربة إلّا من وجهة نظر الخيال”.. سبينوزا تأليف فؤاد زكريا ص 205.
وجهة نظر الفنان تحصنه من الاستنساخ، وهي التي تمنح معنى لمكونات الطبيعة الخام. يشرح شابن في سيرته كيف يسري هذا في عالم الفن قائلا: “الطبيعة عادية، والمحاكاة أكثر إثارة للاهتمام”.. قصة حياتي ص 282. سيرة شابلن.
حين تغيب المحاكاة يقع الفيلم في الميكانيكية بلا أفق. لم يرتفع المخرج من قانون الطبيعة القاسي والكئيب. حتى حين ينادي الطيبون بالتعاون، يحصل أن كل تضامن عفوي إرادي يجلب المصائب لأصحابه وبعدها ينقطعون عن سلوكيات التضامن.
هذه رؤية سوداوية تليق بفرديريك نيتشه، سوداوية تنكر الأمل في تعاون البشر لصنع الخير لأنفسهم، بل وتزعم أن أصحاب القلوب الطيبة لا يعيشون طويلا.. يبدو أن هذا هو سبب رثائهم المبالغ فيه على صفحات “فايسبوك” هذه الأيام.
[embedded content]