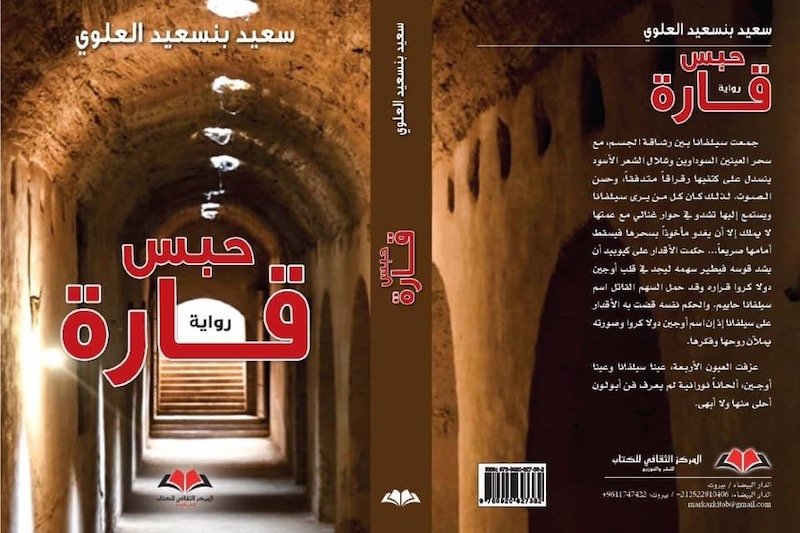ترددت أصداؤهما في بعض محاكم المغرب، وقد طرحهما بعض اليسار الجذري (من تنظيم “إلى الأمام” و”23 مارس”) وقد تحرر من الأحزاب الرسمية التقليدية، وترددتا في العالم (محكمة العدل الدولية، مجلس الأمن…).
والصحراء المغربية قضية مقدسة، مقدسة لأصحابها في المغرب؛ أبانت عن قوة الإيمان بالقضية، وغيرت قناعات، وفتحت باب المراجعات، وباب العفو ومعانقة الحرية، وباب البحث في التاريخ والتأليف… وهي “مقدسة” عند أعدائها، عسكر الجزائر منذ استشاط الكولونيل الراحل بوخروبة، المعروف ببومدين، غضبا وحقدا حين أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية عن المسيرة، فأرغى وأزبد كما سجل ذلك الصحافي صديق الطرفين (الملك الحسن الثاني وبوخروبة الأول): جان دانيال.
وبنى عقيدة العسكر الجزائري على العداء للمملكة الشريفة وريثة الإمبراطورية العربية الأمازيغية التي امتدت جنوبا إلى تومبوكتو، وشمالا إلى الأندلس. رحل بومدين، ورحل الذين جاؤوا بعده، وكانوا نسخة منه باستثناء الشهيد بوضياف، ومنهم ابن وجدة بوتفليقة، وما تزال عقيدة العداء سارية المفعول، ولو أن الصحراء المغربية تقود بلاد العسكر إلى الإفلاس، كما أدت ثلاثة أعراس بالخزينة إلى الإفلاس في غابر الزمن. فما بالك بخمسة وأربعين عرسا على امتداد خمس وأربعين سنة؟
ولكن كثيرا من الماء جرى تحت الجسر؛ فموقعة الگرگرات، والاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، والقنصليات التي تزين صدر العيون والداخلة، والاستثمار الذي سيحول المنطقة إلى قطب اقتصادي آخر… والحراك الشعبي الجزائري المبارك المطالب “بتنحية العسكر كاملين”… كل ذلك قادر على أن يبعث وحدة المغرب الكبير ليستطيع مواجهة الإمبرياليات الغربية ككتلة بشرية واقتصادية.
لو كان فيها عسكري واحد يحكمها، “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، كما كان عسكري واحد يحكم “الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى”، لاستطاع التراجع كما قام بذلك الراحل معمر القذافي حين أيقن أن الصحراء المغربية قضية وطنية. لكن طغمة عسكرية، شبيهة بالتي وأدت الحريات في أمريكا اللاتيتية، هي التي تكتم أنفاس الشعب الجزائري العظيم ككل الشعوب.
لكن، السؤال الذي يحير الأذهان، ماذا أعطت الأحزاب “المغربية” لقضية الصحراء المغربية؟
ما عقدت “الأحزاب المغربية” مؤتمرا بالداخلة أو الگويرة، أو بمحاذاة الجدار الذي أودى بأحلام العسكر الجزائري وأذنابه بله بالمنطقة العازلة، فيشعر المواطنون بنخوة الممثلين السياسيين، كما تشعر القوات المسلحة الملكية الباسلة المرابطة هناك بالدعم الشعبي.. منذ استرجاع الصحراء المغربية إلى الآن، وطيلة كل سنوات الصراع مع عسكر الجزائر.
أما كان أولى بزعماء تلك الأحزاب، وخاصة التي تعيش على ريع المعاشات، والغرفة الثانية، وكافة الامتيازات (دعم جرائدها وحملاتها الانتخابية، وبيع التزكيات…)، وريع تصفية المعاشات الذي ناقشوه بحمية وظفروا به، في لحظة يعرف العالم إحياء مفهوم التضامن، وجائحة كورونا، أن يقفوا وقفة عز، ويتفقوا بالإجماع على التنازل عن كامل مقدار التصفية ليساهموا في المجهود الوطني عبر بناء مدارس للتكوين التقني، كما بنى رجال وطنيون مدارس بشمال المملكة، منهم عبد الله گنون، والمكي الناصري… هم الذين ناقشوا بحمية القاسم الانتخابي ليضمنوا كراسي وأموال وامتيازات؟
الصحراء تسائل تحرير الفكر المغربي
في سياق كفاحنا لحماية مناطقنا الجنوبية من مخططات تقسيم أمتنا وإبقائنا معرضين لخطر مواجهة التهديدات الخارجية، تخلينا عن نعت “التقدمي” وتنازلنا عنه لمن يسمون بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحت ستار العدالة الاجتماعية، يعتقد العديد من اليساريين في الغرب، وفي إفريقيا ذاتها وأجزاء أخرى من العالم، أن عليهم الالتزام بالدفاع عن المستضعف ضد دولة كبيرة مثل المغرب. يعتقد هؤلاء اليساريون أنهم يحاربون الاستعمار، لكن يلاحظ أن فهم هؤلاء للتاريخ إما ضعيف جدا حتى يبلغ درجة الخطورة بله الجريمة أو يعاني من نظرة أنانية تخدم مصالحهم عن عمد بحيث ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا عملاء غير معتمدين أو غير واعين بذلك للإمبريالية الغربية.
لقد حان الوقت للمثقفين اليساريين المغاربة والنقاد الثقافيين التقدميين ليبينوا لهؤلاء المناضلين الزائفين، ويبرهنوا لهم أن المغرب كأمة هو الضحية الرئيسية للدعوات الجوفاء من أجل حرية “الشعب الصحراوي”.
وتكمن المشكلة الرئيسية مع أولئك الذين ينتقدون المغرب في أنهم يتعاملون مع القضية من منظور مركزية-أوروبية متحيزة، بما في ذلك طريقة التعامل مع فكرة حقوق الإنسان، وهي فكرة تم تطويرها لتعكس نوعا معينا من التجربة الإنسانية-وبالتحديد التجربة الرأسمالية الأوروبية-وليس التجربة المغربية.
وليس هناك ما هو أكثر إهانة من مشاهدة الغرب يبشر بحقوق الإنسان والديمقراطية للشعوب والثقافات التي ظل يدمرها عبر قرون من الاستغلال والقهر.
ومنذ عقود خلت، ندد الباحث الهندي وينين بيريرا بمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الذي يسيطر عليه خمسة أعضاء، باعتباره “أكثر المؤسسات غير ديمقراطية لا مثيل لها على هذا الكوكب”، ومع ذلك فإن هذه المؤسسة هي التي تصدر الأحكام الخاصة بهذه الحقوق بالنسبة لجميع الثقافات والأمم عبر العالم. ويعتبر هذا المجال فضاء مفتوحا على مصراعيه لفحص نقدي جديد، خاصة إذا أردنا حماية ما تبقى من إنسانيتنا في مواجهة الاعتداءات المستمرة من قبل المؤسسات ووسائل الإعلام الغربية.
ومثلما نحتاج إلى وضع فكرة حقوق الإنسان في سياق تاريخي، نحتاج أيضًا إلى فهم سيميائية هذه الحرب على المغرب وكيف يمكن للغة أن تضللنا حتى ننسى تاريخنا الخاص.
ولما كان الأمر يتعلق بثقافة قانونية بامتياز، فإن اهتمام الغرب بهذا الموضوع يعود إلى عام 1975 فقط، عندما أطلق الملك الراحل الحسن الثاني المسيرة الخضراء وبدأ الصراع مع البوليساريو. ولأن اللغة مهمة جدا، فقد تم تصنيف مناطقنا الجنوبية على أنها “الصحراء الغربية” في الخرائط الدولية لتعميق الانطباع بأننا بصدد كيانين اثنين ونتعامل مع كيانين، وليس كيانًا واحدًا قام بتقسيمه الاستعمار الإسباني.
ومع ذلك، كان عام 1975 تتويجا لمرحلة تاريخية طويلة من المقاومة المغربية للتجاوزات والاعتداءات الفرنسية والإسبانية على السيادة المغربية وكفاح الشعب المغربي الدؤوب لاستعادة أراضيه. ذلك أن مشكلة المغرب بدأت على وجه التحديد عندما تعطل نمط العيش الطبيعي السائد في شمال إفريقيا بالاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830.
ولأن المغرب دعم الزعيم الجزائري المناهض للاستعمار الأمير عبد القادر (الذي أعلن ولاءه للسلطان المغربي مولاي عبد الرحمن)، وجد المغرب نفسه يواجه الجيش الفرنسي الأقوى منه بكثير في معركة إيسلي، كما وجد نفسه مضطرا للتصديق على معاهدة لالة مغنية الشائنة في عام 1845، وبالتالي فقد الكثير من الأراضي لصالح الجزائر الفرنسية.
ومن خلال المفاوضات القسرية وتحت قوة السلاح القاهرة، ضم الفرنسيون تدريجياً المزيد من الأراضي التي كانت تمثل، ثقافياً وعرقياً، جزءاً لا يتجزأ من المغرب.
وكان الصحراويون الذين قاتلوا الاحتلال الإسباني مرتبطين بأواصر الولاء (البيعة) للسلطان ومطوقين بها. وهكذا، فلا عجب أن رفض المغرب، عندما حصل على استقلاله عام 1956، قبول ما يسمى بإعلان القاهرة في العام 1964 (الذي يلزم الدول بقبول الحدود الموروثة عن الأنظمة الاستعمارية)، لأن ذلك سيعني التخلي عن النضال من أجل الاستقلال الكامل، وتحرير باقي الأراضي التي ما تزال تحت الاحتلال.
ويقدم ستيفن أو هيوز، الصحافي البريطاني والمراقب القديم الذي شهد انتقال المغرب إلى عهد الاستقلال، أدلة واضحة تماما بشأن حق المغرب المشروع في مناطقه الجنوبية.
ويذكرنا هيوز في كتابه “برقيات من المغرب” بأن المغاربة ظلوا يطالبون بالصحراء منذ ما قبل الاستقلال، حتى إن حزب الاستقلال نشر خرائط للمغرب الكبير شملت موريتانيا وأجزاء من الجزائر. ولم يكن في ذلك الأمر أدنى نزعة شوفينية أو إمبريالية، بل كان ذلك مجرد إعلان إنهاء لفترة الاستعمار.
وفي عام 1958، ترأس الأمير الحسن مؤتمرا كان هدفه تحرير الصحراء. وبعد ثلاث سنوات (في عام 1961)، التقى القادة الثوريون الأفارقة كوامي نكروما، وأحمد سيكو توري، وجمال عبد الناصر، وموديبو كايتا، والجزائري فرحات عباس وآخرون في الدار البيضاء مع محمد الخامس لتشكيل مجموعة الدار البيضاء و”مناقشة أزمة الكونغو، وتحرير فلسطين، وحرب الجزائر، ومطالبة المغرب بالصحراء الغربية وموريتانيا”، والوحدة الأفريقية.
وبعد الاستقلال، انخرط جيش التحرير المغربي المتمركز في منطقة الريف في جيش التحرير الصحراوي حيث أعاد توجيه تركيزه نحو المنطقة الجنوبية التي كانت ما تزال تحت الاحتلال. ووصل مقاتلو هذا الجيش إلى العيون والداخلة (المعروفة آنذاك باسم فيلا سيسنيروس) سنة 1958، ولكن كما حدث مع عبد الكريم الخطابي في الريف، تم صد مقاتلي جيش التحرير من خلال عملية عسكرية فرنسية إسبانية مشتركة أطلق عليها اسم أوراغان/إيكوفيون.
وفي عام 1969، نشر فرانك إي تروت، وهو أكاديمي من جامعة هارفارد، كتابا يعرض بالتفاصيل الدقيقة للطريقة التي تم بها ضم مناطق شرق الصحراء المغربية من لدن الفرنسيين، بشكل منهجي، عندما كانوا ينشئون الجزائر من الصفر. وقد قدر معجم “لاروس” الفرنسي عام 1888 مساحة المغرب بـ 812 ألف كيلومتر مربع، ولكنه قلصها في طبعته لعام 1897 إلى 800 ألف، وفي عام 1956 أصبحت 430810 كيلومترات فقط، من دون إعطاء أي فكرة عن كيفية تقلص مساحة الأراضي المغربية إلى مساحتها الحالية.
وقد كانت هناك مؤشرات تؤكد أن فرنسا أرادت التفاوض مع المغرب ليستعيد بعض الأقاليم التي سلبت منه، بما في ذلك مدينة تندوف، قبل أن تمنح الجزائر للجزائريين. لكن محمد الخامس الذي كان، مثل كل المغاربة، يدعم حرب استقلال الجزائريين، رفض العرض، وكان واثقا جدا من أن أشقاءه الجزائريين سيعيدون للمغرب أراضيه عند حصولهم على الاستقلال.
ولكن، لسوء الحظ، لم يحدث ذلك.
يقول العديد من المعارضين للمغرب إن الدول الأفريقية قررت العيش داخل حدود استعمارية حتى لا تتسبب في خلق فوضى جديدة. قد يكون هذا أمرا رائعا بالنسبة لتلك البلدان التي لم تكن موجودة من قبل، لكن هذه السياسة تعتبر سخيفة في حالة المغرب الذي كان موجودا كدولة ذات سيادة لقرون خلت. وتنحدر معظم سلالات المغرب من الصحراء وبها نشأت، ومنها المرابطون الذين أسسوا مدينة مراكش وجعلوا منها عاصمة إمبراطوريتهم مترامية الأطراف، وكانوا ينحدرون من تلك المنطقة المتنازع عليها، وعلى الأرجح من موريتانيا.
وقد كانت العلاقات والروابط مع الصحراء تمتد حتى تشمل كل الطريق الموصل إلى السنغال، تتقوى أحيانا وتتراجع أخرى بحسب طبيعة الأحداث التاريخية؛ ولكن في الوقت الذي بدأ فيه الفرنسيون والإسبان مخططاتهم التوسعية في المنطقة، قام معظم سكان شمال السنغال والصحراء الجزائرية بإعلان الولاء والبيعة للسلطان المغربي وأقاموا صلاة الجمعة باسمه. وكانت هذه علامات السيادة في المجتمعات الإسلامية لفترة ما قبل مرحلة الاستعمار، ولم تكن هي الحدود الإقليمية المرسومة بدقة التي كان على الدول الأوروبية أن تنشئها لتسوية نزاعاتها.
كانت المفاهيم الأوروبية الدالة على السيادة مختلفة تماما عن المفاهيم الإسلامية الدالة عليها، ولهذا السبب أسمي أولئك الذين يناصرون نهجا مبسطا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان من أتباع المركزية الأوروبية. إنهم لا يظهرون أي اهتمام بماضي المغرب ما قبل الاستعمار ولا أي عناية. إنهم يتصرفون كما لو أن التاريخ هو اختراع أوروبي.
وإذا رفض المغرب قبول مبدأ قانونيّ أوروبي قائم على أساس مبادئ ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، فذلك لأنه، على عكس معظم الدول المجتمعة والموقعة على الميثاق، كان موجودًا منذ فترة طويلة كدولة ذات سيادة، دولة تعاملت مع القوى الأوروبية، مثل إنجلترا وفرنسا، على قدم المساواة في القرنين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. خذ أي أطلس تاريخي لأفريقيا وتفحصه ويمكنك أن ترى هذا الأمر بنفسك وتلمسه: ذلك أنه على عكس بقية الدول الموجودة على القارة، عاش المغرب دائمًا ضمن الحدود الجغرافية التي تميز البلاد.
وصحيح أن مثل هذه الحدود امتدت، في بعض الأحيان، شرقاً لتشمل ليبيا الحالية-ناهيك عن الجزائر ذاتها-وشمالاً إلى إسبانيا، وجنوباً إلى ما وراء موريتانيا، لكن المغرب لا يطالب باستعادة مثل هذه البلدان-فهو يسعى فقط إلى لَـمِّ شمل الأشخاص الذين عبروا عن ارتباطهم بالسلاطين المغاربة في فترة ما قبل الاستعمار مباشرة. إن هذا السعي جزء من العملية الحديثة لإنهاء الاستعمار-لا أكثر ولا أقل.
ثم إن القانون الدولي ذاته، كما أشار إلى ذلك الباحث جورج جوفي في مقال لم يتم تجاوز مضمونه في العمق التاريخي ونزاهة الرأي والحياد، لا يسمح بالتغاضي عن تقطيع أوصال شعب أو أمة ولا يقبل بذلك. ويعتمد خصوم المغرب على مبررات تاريخية واهية وعلى الكثير من الفلسفة الاستعمارية (مفهوم القانون الروماني القديم (uti posseditis) الذي تتعهد بمقتضاه الدولة الجديدة بالحفاظ على حدود الأراضي التي وجدت عليها)، والأحكام الغامضة أو المتناقضة في القانون الدولي، كما أشار إلى ذلك جوفي.
إن الحل الذي يقترحه المغرب الآن وتؤيده الولايات المتحدة-وهو الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية-ليس أداة للتحايل على القرار الذي ترعاه الأمم المتحدة؛ إنه، في رأيي، مجرد نسخة حديثة من مبدأ البيعة القديم الذي ربط الصحراويين على الدوام ببقية البلاد. ذلك أن السلطان وجيشه لا يمكنها أن يكونا في كل مكان في وقت واحد، وكان الحكم الذاتي الكبير هو الحل الفعلي للحكومة خلال فترات ما قبل الاستعمار. وما دام الناس يدفعون الضرائب ويعترفون بالسلطان عبر أداء صلواتهم باسمه، فقد تُرك لهم اختيار إدارة شؤونهم على النحو الذي يرونه مناسبًا.
وعلى نحو معين، فإن استعادة مقاطعاتنا الجنوبية هي شكل من أشكال التحرر من المفاهيم الأوروبية المنحازة التي قوضت وجود الشعوب غير الأوروبية وكينونتها منذ فترة طويلة في التاريخ الحديث.
ويمكن للمثقفين واليساريين المغاربة أن يلقنوا زملاءهم الغربيين ويعلمونهم أن التاريخ لم يبدأ أبدا في عام 1975، وأن الدول لم تنشأ وتولد مع صلح وستفاليا في القرن السابع عشر، وأن قضايا السيادة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالثقافة والتقاليد الخاصة بكل شعب. وبينما نحن نكمل استعادتنا للصحراء، فإننا نطالب أيضًا بحقنا في تقاليدنا الخاصة بنا، وتفكيرنا المستقل.
وهذا شيء جدير بالاحتفال والاحتفاء به.