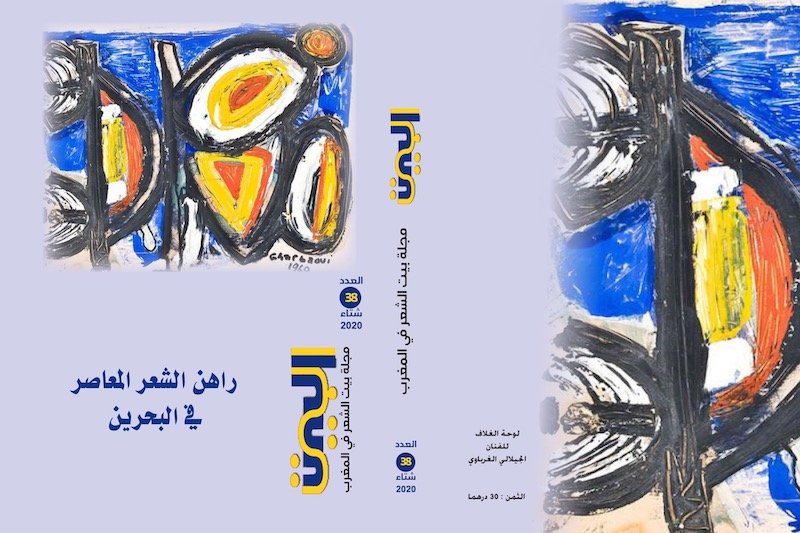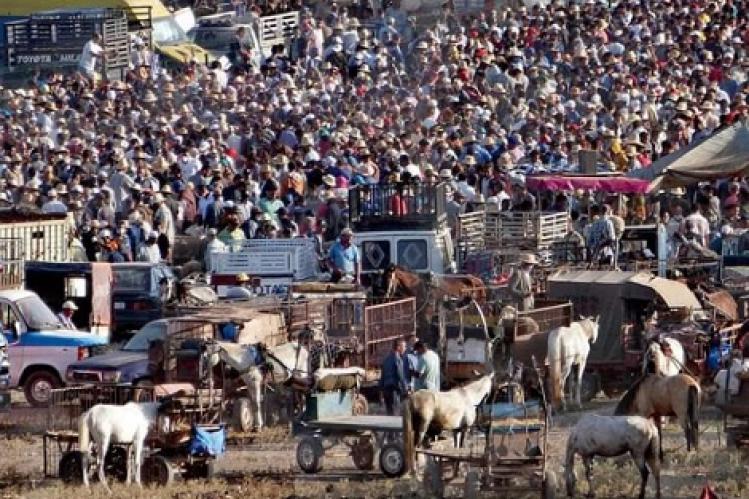من يتحكم في من؟:
منذ عقود خلت ومقولة كون التكنولوجيا والآلة ستأخذ محل الإنسان في جل مجالات عمله وحياته العملية، تُعدّ من المقولات الأكثر رواجا و”تهديدا” للفرد العامل! فهل فعلا ستغدو الآلات أكثر ذكاء وقوة مما هي عليه الآن، وتحتل كل الفضاءات الحياتية؟ بل هل ستنتصر يوما ما على الذكاء البشري وتتجاوزه؟ وذلك في ظل ما نشهده من تطوير لروبوتات وبرامج التعلم الذاتي. وإنْ كان الجواب بـ”نعم”! فهل مستقبلنا هو مستقبل سيبراني محض، حيث سوف تُنشأ مجتمعات سيبرانية Cybersociétés يُهمشُ فيها الإنسان ويصير غريبا عن عالمه الذي أنشأه؟ بل كيف سنجد أنفسنا أمام هذا المستقبل حيث يغدو كل شيء مبرمجا وقابلا للبرمجة، وتصير الروبوتات مطوّرة لبرامجها الخاصة ذاتيا؟: كاملة الاستقلال بهذا المعنى. وعن أي مفاهيم أخلاقية سنتحدث في تلك الحالة ونحن أمام مجتمع “تتحكم” فيه الآلة؟ إننا بهذا نتجه جهة عالم جديد حيث نستبدل كل “الميتافيزيقيات” السابقة بميتافيزيقيا جديدة، إنها “ميتافيزيقيا التقنية” بلغة هايدغر، حيث نغدو منصاعين لكل أوامرها ومسيرين بها في تفاصيل يومنا كله؛ إننا نطور ما سيطوّرنا. فقد حققت هذه الميتافيزيقيا المعاصرة حلم الميتافيزيقا الأزلي لما جعلت المعرفة ملتحمة بأشياء تلمسها وتعيها الذات العارفة. لقد غدت جزءا لا يتجزأ من اليومي والبشري. بل إن الإنسان في هذا العصر كما يقول هايدغر بات “بدون سلطة على مصير الوجود، وبالتالي لا يجب عليه أن يشرع في أي نشاط أو تمرد، وإلا سقط في فخ الفكر [الأداتي] الحاسب والتقانية، فلا يوجد فعل إنساني يمكنه أن يغير جوهر التقنية”؛ إنها إذن، ميتافيزيقيا تتجاوز صانعها: الإنسان. بل ما زال صوت فيلسوف المطارق، نيتشه، صداحا وهو يردد، رغم –في مفارقة مدهشة- دعوته إلى الإنسان المفارق، “احذروا من التقدم التكنولوجي الذي لا غاية له إلا ذاته، احذروا من حركته الجهنمية التي لا تتوقف عند حد، سوف يولد في المستقبل أفرادا طيعين، خانعين، مستعبدين، يعيشون كالآلات، احذروا من هذه الدورة الطاحنة للمال ورأس المال والإنتاج الذي يستهلك نفسه بنفسه، احذروا من عصر العدمية الذي سيجيء لا محالة. إذ لا يكفي أن تسقطوا الآلهة القديمة لكي تُحِلُّوا محلها أصناما جديدة، لا يكفي أن تنهار الأديان التقليدية لكي تحل محلها الأديان العلمية، فالتقدم ليس غاية بحد ذاته”؛ لم يكن صوت نيتشه هذا ضد التقدم في حد ذاته، بل ضد فصل الإنسان عن تقدمه الطبيعي المحتوم نحن التسامي والارتقاء وربطه بـ”ميتافيزيقيا” بديلة عن كل تلك الميتافيزيقيات التي حاول صاحب “ما وراء الخير والشر” هدمها.
المستقبلُ مستقبليْن:
إننا اليوم على أعتاب المستقبل المغاير لكل ما فكرت فيه البشرية من ذي قبل، مستقبل لا تتحكم فيه اليد البشرية فحسب، بل تشاطرها ذلك تلك الأيادي الميكانيكية وتلك البرامج الحاسوبية الفائقة، حواسيب تغير “جلدها” نحو مستقبل كمومي فائق السرعة والدقة. وإنك اليوم تستطيع أن تجلس في مدينة نيويورك في منزلك الدافئ، لتتحكم في مجريات مزرعتك في مدينة أسترالية، كل ذلك عبر الكبس على أزرار هاتفك الذكي! فالعالم وبفعل هذا التحول الجذري، في نظر المفكر الاقتصادي الأمريكي جرمي رفكين، يتجه إلى منحى جد خطير، وينقسم إلى قطبين، الأول يتشكل من نخبة المهندسين والباحثين والمتحكمين في تكنولوجيا المعلومات المتفوقة (المبرمجين)، ومن جهة الأخرى قطب العمال الذين تعد وظائفهم مهددة، فلم تتبقى هناك مهن قارة وثابتة في عالم يصير أكثر أتمتةً Automatisé وخاضعا للآلة والذكاء المعلوماتي. “فهل [إذن] لم يعد المستقبل في حاجة إلينا؟”، أو بالأحرى يمكن أن نطرح السؤال بصيغة الميليونير بيلي جوي Billy Joy: “لماذا لم يعد المستقبل في حاجة إلينا؟”. يجيب هو عينه بتأكيد قاطع عن ذلك، قائلا “إن المستقبل ليس -ولن يكون- في حاجة إلينا”. إننا إذن بهذا المعنى، نصنع مستقبلا سوف يلغي كل ضرورة تحكمنا فيه، بل سوف يلغي وظائف ومهام إنسانية كبرى !!. ولأننا لا نستطيع الانفلات من المستقبل الذي “لم يأت بعد” دائما، مستقبل مرجأ على استمرار، فنحن على الدوام مهووسون به، وبصناعته وباستباقه، فـ”النفس تمتلك المستقبل على نحو مستبق” كما يطرح ليبنتز. فنحن نطّلع دائما إلى المستقبل ونرسم معالمه قبل بلوغه؛ فكم من عمل أدبي وخيالي استطاع النجاح في التنبؤ بشيء من هذا “المستقبل/الحاضر” الذي نحياه. كأن المستقبل هو “ماض” (فكرة) يطاردنا، أو قدر محتوم مهما فعلنا فنحن مشدودون إليه ومنذورون لعيش أحداثه التي نحن طرف في صناعتها. لهذا يُقسم ليبنتز المستقبل إلى شقين، “مستقبل بالضرورة”، إنه ذلك الذي يحدث على وجه اليقين دون أن يكون لنا أي دور فيه، لأنه منذور إلى قوانين الطبيعة التي تتحكم فيه؛ و”مستقبل مشروط”، وهو أيضا مستقبل يأتي على وجه القين، لكنه دائما منوط بشيء أو بأمر أو بحدث ما، أي ليس حادثا بالضرورية.
أعتاب “المستقبل”:
المستقبل إذن حادث لا ريب، سواء تدخلنا بوعي أو لاوعي. وها نحن على أعتاب حقبة تاريخية حيث سيكون كل ما نقوم به مستقبلا يدخل ضمن “المستقبل بالضرورة”، حيث قد لا يبقى للإنسانية أي دخل في ما سيحدث، وإن كانت هي صانعته. ما سيجعلنا بالتالي، أمام ضرورة إعادة التفكير في “الشرط الإنساني”، في الوجود البشري.. في الأخلاقيات البشرية والفكر والعقل البشري وفي الواقع أيضا، حيث سينفلت المستقبل من بين أيادينا. وما يستوجب معه اليوم، كما يطرح فلاسفة أمثال ليوتار، إعادة التفكير في كل تلك المفاهيم الفردانية والاستقلالية التي خلقتها الحداثة ونحن نعرج صوب عصر قد يُهمش فيه الفرد البشري.
تخترقنا التكنولوجيا إلى أقصى حد، بل باتت ونحن على أعتاب “المستقبل” هي التي توضب تفاصيلنا اليومية بشكل دقيق إلى الحد الكبير؛ ولم يعد رأس الإنسان ودماغ بين كتفيه، كما يقول مشيل سير، بل بين أصابع يده؛ فالهاتف غدا بديلا عن الأدمغة البشرية، باستطاعته التفكير والحساب والقيام بإحصاءات وأمور معقدة كان يتكفل بها عقل الفرد. بل إنه يستشرف المستقبل عينه ! في الوقت الذي كانت تستخدم العصور القديمة جميع أنواع العلامات (حركات النجوم، تحليق الطيور، سقوط لمطر، الأحلام…) لتوقع المستقبل، فها العالم يستبدل تلك العلامات بما هو رقمي: بالأصفار والآحاد، واحتمالات الفيزياء والرياضيات، حيث صار كل ممكن محتملا ومعقولا وكل محتمل ممكنا وعقولا. بل إننا نتحدث عن المحتمل بصيغة الجمع أمام سطوة النسبية وأفول كل حتمية ممكنة. فكل محتمل يجب النظر إليه بجدية. وهذا ما يتأسس عليه مفهوم “التفرد” في عصر التكنولوجيا والرقمنة.
من التفرد إلى الهُجن:
يقودنا التفرد التكنولوجي إلىْ انعراج زمني حيث إن المستقبل فيه لم يعد طوع يد الإنسان، لكنه يخص نوعا/كائنا جديدا، الذي قد يكون آليا خالصا، أو هجينا بين الإنسان والآلة. فإن كنا نتحدث عن “أنسنة” العالم والأشياء فاليوم إننا أمام بزوغ مفهوم جديد، ألا وهو “حَوْسَبَة الإنسان”، جعل هذا الأخير خاضعا لكل الزراعات الممكنة للشرائح الذكية داخل دماغه وباقي أعضائه الحيوية. أو كما يقول أحدهم، “ستكون الشريحة الحاسوبية ضمن أحذيتنا، التي ندوس عليها، أكثر ذكاء من الدماغ البشري بعد 30 عام”. وبمقابل مفهوم الإنسان الخارق، ذلك الإنسان النيتشوي المتعالي بذكائه وفكره، فالبشرية تصنع “ذكائنا اصطناعيا خارقا”، سيقود إلى بروز ذلك السوبرمان الذي توقع نيتشه، لكن هل سيكون على شاكلة ما تصوره هذا الفيلسوف، كائنا متعاليا على كل الأخلاقيات التي تقود إلى الضعف والشفقة؟ ليسنا هنا لنجيب عن هذا السؤال الفلسفي والأخلاقي الكبير، لكننا نجد أنفسنا أمام انعطاف بشري كبير، يقود إلى خلق “جنس” جديد وهجين… فهل سنظل نطلق عليه لقب: “إنسان”؟!
الشراكة والصراع:
سبق وتحدث إيلون ماسك Elon Musk، سنة 2017، عن إمكانية التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي، وقد عقب أحدهم قائلا “أعتقد أن هذا الذكاء الخارق سيكون شريكاً لنا. إذا أسأنا استخدامه، قد نعرض أنفسنا للخطر. أما إذا استخدمناه بنية حسنة، سيكون شريكنا لبناء حياة أفضل”. فمن سيضمن إذن، “النية الحسنة” من عدمها أمام نسبية كل شيء وإمكانية كل الاحتمالات؟ في هذا الصدد سعى فيلم الخيال العلمي Transcendance لمخرجه Wally Pfister، (عمله الفردي الأول)، الصادر سنة 2014، إلى الإجابة عن المدى الذي تستطيع التقنية الوصول إليه، وعن التمثُلات الضارة الناتجة عن تلك التجليات المستقبلية لها. في ربع الساعة الأول للفيلم يظهر ثلاث علماء في الفيزياء التطبيقية والنانومترية، يحاضرون حول آخر ما توصلوا إليه من محاكات للعقل (عقل القردة)، عبر آلة كبرى “PINN” تستطيع حل كل مشاكل الإنسانية. فإذا بأحد الحاضرين يسأل ( Dr Will Caster (Johnny Depp، هل عبر هذه الآلة يسعى لخلق إله جديد؟. هذا السؤال المحرك الرئيسي لأحداث الفيلم. يجعلنا نطرح تساؤلات لا حصر لها مفادها هل غاية الكائن أن يقنّن الطبيعة أو ليصير إلهاً عليها؟ وهذا لا يمكنه أن يتمثّل ويُتاح له إلا عبر التقنية وتجسيداتها. تكمن فكرة الفيلم في إمكان الإنسان أن يعبُر بالتكنولوجيا إلى أقصى مداها، بقدر ما تستطيع هي أن تصل إلى أبعد ما يتصوره هذا الكائن. وإن تنتصر العاطفة البشرية في أخر الفيلم، فقد ظلت “الآلة” تحمل “روحها” رغم تدميرها، وإمكانية إعادة “إحياء” نفسها من جديد بمعزل عن يد البشر..
إنْ كان يرى “ديكارت” أنه من أجل سيادة الإنسان على الطبيعة وتسخيرها لمصلحة الإنسان يجب الانتقال من الفلسفة النظرية إلى الفلسفة التطبيقية التي تحيط بمبادئ الطبيعة، وقوانينها. هذه الفلسفة التطبيقية التي تجد تجلياتها في الآلة والتقنية. غير أن ” ميشيل سير” يدعو إلى تجاوز معنى التقنية كما حدده ديكارت نحو تقنية مقننة تخضع لجملة من القواعد والقوانين التي تجعل الإنسان يسير التقنية لخدمة الطبيعة وما يسميه بالعقد الطبيعي. في اتجاه آخر يذهب “جون جاك روسو” وغيره إلى الاعتقاد بأن التقدم التقني هو سبب كل مصائب البشرية، إلا أن لم يدعو إلى التخلي عنه كما هو الحال عند “هوتا”، الذي ينظر إلى التقنية باعتبارها وهما يستعبد الإنسان، لكونها حاملة لمخاطر ضد الإنسانية، ويدعو إلى العودة للتقليد الأصيل الذي يسميه الرمز والكلمة. عديدون هم من تناولوا المصطلح والمفهوم بشكل فلسفي وغاصوا فيه.. إلا أننا لا يمكننا إنكار بأن التقنية، ضرورة إنسانية، لا يمكن الاستغناء عليها.. لما لها من دور حيوي في كل تجليات الإنسانية اليومية. وحينما تتحكم عليها تلك النزعة للسيطرة، تصير تهديدا للإنسانية وبقائها، كما الطبيعة..
أي مستقبل للمستقبل؟:
صرنا إذن، مرهونين بالتقدم التكنولوجي غير قادرين على الخروج من تلابيبه، محكومين بتكوره ومنذورين لمستقبل تتحكم فيه التكنولوجيا كليا أو جزئيا، غير إننا لن نستطيع الانفلات أبدا من “ميتافيزيقيا” التكنولوجيا، التي سوف ترسم أخلاقيات المستقبل وأفكاره ورؤاه. بل إننا نصير إلى عالم جديد ترسمه ما يسميها مشيل فوكو بـ”التكنولوجيا السياسية”، التي تخدم في إصلاح السجناء، وعلاج المرضى، وتعليم الأطفال في المدارس، وحصر حالات الجنون، والإشراف على العمال، وإجبار الشحاذين والمتسولين على العمل، الخ… سياسة تراقب كل حركاتنا وذبذباتنا، إنها البديل عن “الأخ الأكبر” بتعبير جورج أورويل، ترصدنا كما ترصد شاشات الرصد شخوص روايتها 1984. إنها “سلطة” تراقبنا وتضبط علاقتنا الاجتماعية وتشرف حتى على إرادتنا، فتخادعنا لتخبرنا بأنها نابعة من الداخل والضرورة، لحماية أمننا وأجسادنا… كأنها جزء من ضميرنا، لكنها حسب صاحب “حفريات المعرفة”، تسعى لترويض الفرد وسلوكه من خلال ضبط مواقعه وحركاته، عبر الحجر والمراقبة والإشراف المستمر على سلوكياته وحتى نظامه الغذائي والصحي.. فأي مستقبل للمستقبل إذن؟