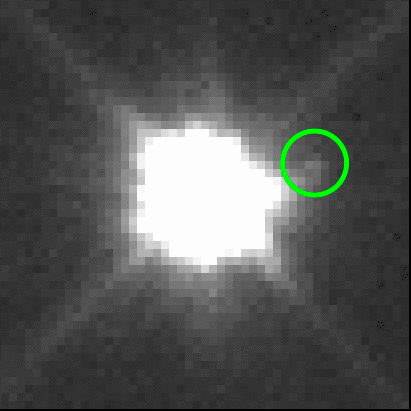- تريسي دينيس-تيواري
- بي بي سي فيوتشر
قبل 50 دقيقة
عندما ولد ابني بمرض خلقي في القلب، كأي أم، شعرت بالضياع. كان بحاجة إلى إجراء جراحة القلب المفتوح، وسيطر عليّ شعور طاغ بالقلق مما قد يحمله المستقبل. كنت أدرك أن النتيجة قد لا تكون جيدة، لكنني كنت أعلم أيضا أنه من الممكن أن تكون النتيجة إيجابية إذا ما وفرت له أفضل رعاية ممكنة.
في أوقات كهذه، من الصعب التركيز على الإيجابيات، لكنني تعلمت أن بإمكاني استغلال القلق لكي أحتفظ بطاقتي ونشاطي. بسبب إدراكي أن المستقبل غير مضمون ولكنني أستطيع أن أؤثر على النتائج، ساعدني قلقي على الصمود في موقف كان يبدو ميؤوسا منه. أعتقد أن القلق من الممكن أن يصبح أداة تساعدنا على التكيف مع التحديات التي تلقيها الحياة في طريقنا.
بيد أنه بالنسبة للكثير من الناس، القلق قد يكون خانقا، كما أنه أصبح مرادفا للمشاعر السلبية.
عندما كنت شابة صغيرة في الثمانينيات من القرن الماضي، كانت كلمة القلق تعتبر اختصارا لمشاعر الضيق والانزعاج. كيف يسير التحضير لحفل زفافك؟ يسير على نحو جيد، ولكنني أشعر بالقلق. كيف يسير العلاج الكيميائي؟ مرهق ومقلق للغاية، ولكن تحت السيطرة.
واليوم، يبدو أننا نعيش في عصر القلق. يوضح موقع Google Trends أن البحث عن كلمة “anxiety” (القلق) ارتفع بنسبة 300 في المئة منذ عام 2004. القلق يلازمنا باستمرار، وهناك سبب وجيه لذلك. فحوالي 31 في المئة من سكان الولايات المتحدة يتعرضون لنوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق في مرحلة ما من حياتهم، ويتراوح ذلك من اضطراب القلق العام، إلى اضطراب الذعر، إلى اضطراب القلق الاجتماعي – وهو النوع الأكثر شيوعا.
بعيدا عن التشخيص الطبي، يبدو أن الكلمة تسللت أيضا إلى لغتنا العامية، وأصبحت تشير إلى عدم الارتياح – فالشخص يشعر بالقلق إزاء تقديم شرح تفصلي، أو مواعدة شخص لم تسبق له رؤيته أو البدء في وظيفة جديدة. لقد أصبحت الكلمة واسعة الانتشار وتشربت بالمعاني المختلفة لتشمل كل شيء من الخوف إلى الترقب اللطيف. وكثيرا ما يؤدي مجرد استخدام الكلمة إلى إلقاء ضوء سلبي على تلك التجارب ويضفي عليها شعورا بالخطر أو بأن شيئا ما لا يسير كما ينبغي.
ثم تأتي اضطرابات القلق، وهي الأكثر شيوعا بين تشخيصات أمراض الصحة العقلية، كما أنها أكثر انتشارا من الاكتئاب والإدمان. يشخص المختصون مئات الملايين من الناس عبر أنحاء العالم بالإصابة بشكل من أشكال اضطرابات القلق في مرحلة ما من مراحل حياتهم. وتواصل معدلات تلك الاضطرابات ارتفاعها، ولا سيما بين الشباب، كما كان الحال على مدى العقدين الماضيين. ولكن هناك العشرات من العلاجات التي تم التحقق من نجاعتها، و30 نوعا مختلفا من أدوية القلق، والمئات من كتب المساعدة الذاتية الرائعة، والآلاف من الدراسات العلمية الدقيقة. فلماذا فشلت تلك الحلول فشلا ذريعا في تقليص حجم المشكلة ؟
كما ذكرت في كتابي “Future Tense”، من بين أسباب ذلك الفشل هو أن المختصين في علاج الصحة العقلية، وأنا منهم، ضللوا الناس في الماضي بدون أن يقصدوا فيما يتعلق بطبيعة القلق – وهو سوء فهم أضر بنا جميعا. أقترح مقاربة جديدة أكثر فائدة وأكثر تفاؤلا لفهم القلق والتعايش معه في القرن الحادي والعشرين – ألا وهي أن تستخدمه لصالحك.
لطالما اكتسبت المشاعر السلبية كالقلق سمعة سيئة لا تستحقها. الشاعر الروماني القديم هوراس كتب قبل أكثر من 2000 عام أن الغضب جنون مؤقت. ولكن خلال الأعوام الـ 150 الماضية، بدءا من كتاب داروين “The Expression of Emotion in Man and Animals” (“التعبير عن العاطفة عند الإنسان والحيوان”)، بدأنا في واقع الأمر نفهم أن مشاعر كالغضب والخوف والقلق نافعة أكثر من كونها خطيرة. فالمشاعر، كإصبع الإبهام واللغة، أدوات للبقاء تشكلت وصُقلت أثناء عملية التطور التي مر بها البشر على مدى مئات الآلاف من السنوات من أجل حمايتهم وضمان ازدهارهم. وهي تفعل ذلك من خلال توفير أمرين: المعلومات والتأهب.
القلق هو معلومات عن مستقبل غير مؤكد: هناك احتمال أن يحدث شيء سيء، ولكن هناك أيضا احتمال أن يحدث شيء جيد. القلق هو أن تنتظر أن تأتي نتيجة اختبار كوفيد إما إيجابية أو سلبية، أو تترقب ذلك الحوار الصعب مع مديرك الذي قد يسير على ما يرام، أو قد يحدث العكس. بيد أن القلق ليس معلومات عن تهديدات مؤكدة وموجودة بالفعل – فهذا يعتبر خوفا، مثل رؤية زعانف سمكة قرش في مياه البحر على بعد أمتار فقط من البقعة التي تسبح فيها. الخوف بالأساس يهيئنا للمواجهة أو الفرار أو الجمود في مكاننا، في حين أن القلق يساعد في بناء الحضارات. فهو يؤهبنا للمثابرة، لأننا نظل يقظين، وللتصرف بطرق من شأنها تفادي وقوع كوارث في المستقبل، ولكن أيضا تحويل الاحتمالات الإيجابية إلى واقع.

صدر الصورة، Getty Images
من الممكن أن يساعد الشعور بالقلق في تهيئتنا للتجربة التي نحن على وشك خوضها
عندما نشعر بالقلق، فإننا لا نصبح فقط أكثر إبداعا وابتكارا، ولكن أدمغتنا تستجيب كذلك بتركيز وفاعلية أكبر عندما نواجه أمرا لا يمكن التنبؤ به. ومن ثم فإن القلق أكثر من مجرد “دوائر الخوف” في الدماغ. فضلا عن ذلك، يؤدي القلق إلى تفعيل رغبتنا في الحصول على مكافئة وفي التواصل الاجتماعي، ما يحثنا على أن نعمل من أجل تحقيق الأشياء التي نهتم بها، ونتواصل مع الآخرين ونصبح أكثر إنتاجية. ولهذا، فإنه من منظور نظرية التطور، فإن القلق ليس مدمرا. القلق يجسد منطق البقاء.
ومع هذا، فإن نظرية التطور وأبحاثها لم تتغلغل في الوعي العام – أو في وعي غالبية المتخصصين في مجال الطب النفسي. فبدلا من التعامل مع القلق على أنه حليف محتمل، فإننا نعامله كعدو.
وفي حين أن اضطرابات القلق من الممكن أن تصيب حياة الشخص بالشلل، فإن الاستخدام الشائع لمصطلح القلق بمعنى شعور سيء بشكل عام يمثل مشكلة، لأنه يعني قبولنا بمغالطتين رئيسيتين: أولا: أن الشعور بالقلق خطير ومدمر، وثانيا: أن الحل الوحيد للتخلص مما يسببه من ألم هو منع القلق أو استئصاله. إنها طريقة تفكير جعلتنا ننظر إلى مشاعر القلق اليومية على أنها أعطاب يجب إصلاحها. لكن وحدها اضطرابات القلق – عندما يتداخل شعورنا المفرط بالقلق ومحاولاتنا التكيف معه حياتنا اليومية – تعتبر أمراضا عقلية. مشاعر القلق، في المقابل، من الممكن أن تكون صحية وطبيعية، بل ومفيدة كذلك.
ذاك المنطق المتعنت الذي يستخدم في تشبيه القلق بالمرض يجعلنا نعطيه حجما أكبر من حجمه الفعلي: كما هو الحال بالنسبة للأمراض الأخرى، سواء كانت أمراضا معدية أم سرطانات، فإننا لن نتمتع بالصحة العقلية إلا إذا كبتنا القلق، تماما مثلما نقول إن مجرد وجود خلية سرطانية واحدة يعني أننا مرضى.
تشبيهه بالمرض يحاصرنا بدلا من أن يأخذ بيدنا، لأنه يتسبب في أننا نخلط بين القلق الطبيعي واضطراب القلق، ونخاف من أي مشاعر تسبب لنا القلق ونتجنبها ونكبتها بمجرد أن نتعرض لها.
بعكس المرض المعدي أو السرطان، تفادي القلق وكبته سيؤديان بشكل شبه حتمي إلى تضخيمه، وفي نفس الوقت يمنعنا من إيجاد سبل عملية للتكيف معه وبناء مهارات المرونة العاطفية. تخرج حلقة القلق المفرغة عن السيطرة: الشعور بأن القلق شيء خطير، الخوف منه، والفرار منه في نهاية المطاف من خلال كبحه أو تفاديه.

صدر الصورة، Getty Images
ينبغي أن يكون القلق شعورا سيئا من أجل أن ينجح في مهمته
الضرر الناتج عن تشبيه القلق بالمرض لا يتوقف عند هذا الحد. فهو يمنعنا أيضا من إدراك أن القلق ليس مجرد شيء علينا أن نخفف من حدته ونسيطر عليه. فالقلق شيء ينبغي أن نسخره من أجل خدمتنا لأنه شيء تطور من أجل مساعدتنا على المثابرة والابتكار والتواصل الاجتماعي والتحلي بالأمل في وجه المجهول من أجل خلق مستقبل أفضل.
لكن، إذا كان القلق شيئا رائعا بهذا الشكل، فلماذا يؤدي إلى شعور بهذا السوء؟
من الضروري أن يكون الشعور بالقلق سلبيا لكي يؤدي وظيفته. بل إن أصل الكلمة المشتق من كلمات من اللغتين اللاتينية واليونانية القديمة تعني “مختنق”، “يشعر بضيق شديد”، و”منزعج” يعكس ذاك السوء. فقط شيء بهذا السوء بإمكانه أن يجبرنا باستمرار على الوقوف والانتباه، وينجح في جعلنا نعمل بجد لتفادي خطر مستقبلي ونرسم طريقا أكثر إيجابية.
لكن غالبيتنا تعلم أن يتفادى ذلك الشعور المفيد ويتجاهله – وهو ما أضر بنا. تخيل أن القلق مثل جهاز الإنذار الذي يطلق جرسا عند اكتشاف الدخان، ليحذرنا من أن البيت يحترق، ويؤهبنا لاتخاذ إجراء مفيد. ما الذي سيحدث لو أننا، بدلا من الإسراع بالخروج من المنزل والاتصال بإدارة إطفاء الحرائق، تجاهلنا الإنذار، أو انتزعنا بطارية الجهاز، أو تجنبنا أماكن في البيت يكون فيها صوت جرس الإنذار هو الأعلى. إذن، بدلا من أن نستفيد من الإنذار ونطفئ الحريق ونمنع نشوب حرائق في المستقبل، فإننا نأمل وندعو ألا يدمر الحريق منزلنا.
لا يمكننا أن نتجاهل الدور الذي يلعبه القلق المحموم والشدائد التي نمر بها. في بعض الأحيان، لا تتوقف الحياة عن وضع المصاعب في طريقنا، ما يؤدي إلى شعور طاغ بالقلق والتوتر. ولكن مهما كان السبب، فإن الإنصات إلى قلقنا – وتصديق أن ما يقوله لنا ينطوي على حكمة فطرية، وأننا نستطيع أن نستغله لصالحنا – هذه هي الخطوة الأولى على طريق تعلم القلق بالطريقة الصحيحة.
هذا التغيير في طريقة تفكيرنا له أثر إيجابي قوي. على سبيل المثال، أشارت دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أنه عندما طُلب من أشخاص مصابين بالقلق الاجتماعي أن ينفذوا مهمة تتسبب لهم في توتر وإرهاق نفسي بالغ – ألا وهي إلقاء خطاب أمام هيئة من الحكام دون منحهم وقتا للتحضير – ولكنهم دُربوا على اعتبار أن ردود فعلهم القلقة إشارة على أنهم مستعدون لخوض التحدي (بدلا من كونها إشارة على وقوع كارثة)، كان أداؤهم أفضل تحت وطأة الضغوط. كانوا أكثر ثقة في أنفسهم، وأقل قلقا، وكان معدل نبضات قلوبهم أكثر ثباتا وضغط دمهم أكثر انخفاضا عندما ركزوا في مهمتهم وانخرطوا فيها.

صدر الصورة، Getty Images
تعلم التكيف مع القلق قد يساعدنا على التأهب بشكل أفضل لتحديات المستقبل
تعلم الشعور بالقلق بالشكل الصحيح يعني إيجاد طرق للتكيف معه بدلا من الدوران حوله، واستغلال ذلك القلق لتحقيق الأهداف، وإدراك متى يكون غير نافع، وممارسة الانفصال عنه. فلتنظر إلى حلقة القلق الإيجابية تلك على أنها مكونة من ثلاثة أجزاء: الاستماع، الاستفادة والانفصال.
استمع للقلق، فهو يساعد في زيادة تركيزنا ورغبتنا في تحقيق الهدف بينما نقوم بإغلاق الهوة بين ما نحن عليه الآن وما نريد أن نصل إليه. ولهذا فإن القلق ينطوي على الأمل – فنحن نستطيع أن نرى التهديدات المستقبلية، ولكننا أيضا نتجه بأنظارنا صوب الجائزة، ونصدق أننا من الممكن أن نعمل من أجل تحويل النتائج الإيجابية إلى واقع.
ولكن لكي يتمكن القلق من تحقيق ذلك، يجب أن يكون شعورا غير مريح لكي يجعلنا ننتبه وننصت لما يقوله لنا. المشاعر المفزعة، تلك التي لا يمكن تجاهلها، تجعلنا نرغب في الهروب. لذا، عندما يتعلق الأمر بالقلق، الفضول هو أفضل أصدقائنا.
الاستفادة: العثور على معلومات مفيدة من شعورنا بالقلق تأهبنا لتوجيه طاقتنا إلى العمل من أجل تحقيق غايتنا. إعطاء أنفسنا مجالا للتفكير في الهدف يرفع من معنوياتنا ويحسن قدرتنا على التركيز والتعلم. هذه الفوائد قد تستمر لشهور أو حتى لسنوات. عندما نوجه القلق نحو السعي إلى تحقيق الهدف وإعطائه الأولوية، فإن القلق يتحول إلى شجاعة. إنه يقوي عزمنا ويطلق العنان لمواطن قوتنا.
الانفصال: ينبغي الإشارة إلى أن القلق ليس مفيدا أو واضح المعالم في كافة الحالات. أحيانا ما يتباطأ في الكشف عن رسالته. وأحيانا يبدو بلا جدوى – فالحياة حقا مليئة بالتحديات، وأحيانا ما يكون هناك الكثير من المشاعر بدون معلومات مفيدة. فهي تقذف بنا نحو زمن المستقبل وقد سيطرت علينا مشاعر القلق. ما أفضل الطرق للانفصال عن تلك المشاعر؟ ممارسة أنشطة تؤدي إلى إبطائنا وانغماسنا في الحاضر: اقرأ إحدى قصائدك المفضلة أو انشد السلوان في الموسيقى. جرب الاستماع إلى ذلك البودكاست الجديد أو مارس الرياضة. اتصل بمعالجك، أو بصديق دائما ما يساعدك في النظر إلى الأمور بشكل مختلف. تلك هي الأوقات التي نشكل فيها وعينا العاطفي والمهارات التي تمكننا من التكيف مع مشاعرنا العصيبة بدلا من الدوران حولها، وطلب المساعدة عندما نحتاج إليها.
القلق بالطريقة الصحيحة
في عصرنا هذا الذي يتركز فيه الاهتمام على الوباء والاستقطاب السياسي والتغير المناخي، الكثير منا يشعر بقلق غامر على مستقبلنا، ويحق لنا ذلك بالطبع. ولكي نتكيف، تعلمنا أن نتعامل مع ذلك الشعور على أنه مرض يجب الوقاية منه وتفاديه واستئصاله مهما كانت التكلفة.
لكن الحقيقة هي أن ما تعلمناه هو عكس ما ينبغي أن نفعله. المشكلة ليست القلق. القلق هو رسول يخبرنا بأننا نواجه مستقبلا غامضا لا يمكن التنبؤ به وبأننا بحاجة إلى أن نكون أهلا للتحدي، أو يرشدنا إلى الطرق التي ينبغي أن نغير بها حياتنا أو إلى أننا بحاجة إلى العون. ولكن من بين المشكلات الرئيسية هي أن فهمنا الخاطئ للقلق يمنعنا من تصديق أن بإمكاننا السيطرة عليه، ومن الاستفادة من استراتيجيات التكيف والعلاجات الموجودة بالفعل، ومن تعلم كيفية الاستفادة منه. وعندما يؤدي ذلك الفهم إلى مفاقمة شعورنا بالقلق، فإننا نكون أكثر عرضة للانزلاق نحو شعور مدمر بالقلق، أو نحو الإصابة اضطرابات القلق.
المشكلة الأساسية بالنسبة لشخص تم تشخيصه بأحد اضطرابات القلق ليست أنه يعاني من قلق عارم. المشكلة الأساسية هي أن الأدوات المتاحة له من أجل تخفيف وطأة تلك المشاعر تتسبب له في اختلال وظيفي. ويقف ذلك عقبة في وجه اهتمامه بنفسه وعمله وتواصله مع الآخرين وتحقيق ذاته. تغيير طريقة تعاملنا مع القلق بإمكانها أن تساعدنا، بغض النظر عن شدة ما نعانيه من قلق. إننا نشعر بالقلق بدرجة أو بأخرى.
قبل أكثر من 180 عاما مضت، كتب الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيغارد: “من يتعلم القلق بالطريقة الصحيحة يكون قد بلغ من العلم منتهاه”. نحن جميعا نولد مصابين بالقلق. وينبغي علينا أن ندرك أنه رغم أن الشعور بالقلق قد يكون شاقا، وأحيانا مخيفا، فإن باستطاعتنا أن نتعلم كيف نحوله إلى حليف لنا، إلى فائدة، وإلى مصدر للإبداع. عندما ننقذ القلق نكون قد أنقذنا أنفسنا.