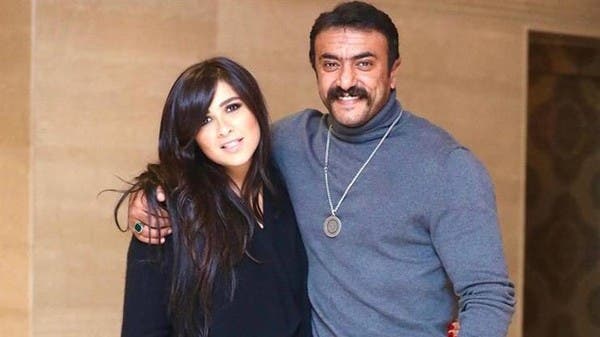يُفاجأ الذي يدلف إلى محترف الفنّان التشكيلي السّوري سعود العبدالله، في العاصمة الأردنية عمَّان حيث يقيم، بحجم تلك السّكينة التي تجلّل المكان. صالة واسعة بأثاث بسيط ومتناسق، طاولة ومزهريّة من الورد، عود يرتاح على أحد المقاعد، ومجموعة من اللوحات يطغى عليها موضوعان: الطبيعة الموشومة بالكثبان والعامرة بالحياة بكل ما فيها، والمرأة التي كان لها النصيب الأكبر من الحضور.
يقول سعود العبدالله في معرض تفسيره لأهمية الريف في أعماله: “إنّها طفولتي وذكرياتي العزيزة عليّ”. وبعد أن صمتَ لحظةً، وكأنّه يستعيد ماضيه البعيد، قال بحماس: “أنا ابن الطّبيعة الأمّ، القائمة في نواحي الحَسَكَة والقامشلي. هبطتُ من الريف ذات يوم، وسافرت بين المدن.
ولكنني بقيت مشدوداً إلى ذلك التشكيل الخرافي الذي شاهدته في شِعاب الطّفولة. ففي فصل الربيع، كنت أُطِلّ على ذلك الامتداد الأخضر الشاسع، الذي لا يكسره إلا التلال الأثرية ذات اللون البُني. هذا الامتداد هو في الواقع لوحة تشكيلية منقّطة. في الصيف يصبح اللون الأصفر هو السّائد. ولذلك، صرتُ أعتمد في لوحاتي على ألوان الطبيعة الثلاثة: الأخضر وهو لون الأشجار، البني وهو لون التّراب، والأصفر وهو لون الحصاد”.
تقوم تجربة سعود العبدالله التشكيليّة على تكثيف عناصر اللوحة في عدد ضئيل من الخطوط والألوان، كما لو كان يرسم بممحاة. ويلجأ أحياناً إلى اختصار اللوحة بخط واحد أو خطّين. ومثل هذه التّقنية تفتح المجال أمام المشاهد الذي يتأمّل العمل، ثمّ يحاول أن يقدّم اقتراحاته الخاصّة لإكماله. وبهذا الأسلوب الجميل، يصبح المشاهد طرفاً آخر إلى جانب الفنّان في رسم اللوحة.
وعند إبداء الملاحظة أن هذه المناظر الطبيعية تبدو في لوحاته اختزالاً لما هي عليه في الواقع، قال العبدالله: “اللوحة التشكيلية التي أرسمها هي لوحة بسيطة، مثلها مثل هذه الطبيعة الريفية، لا ينبغي أن تكون مخزناً للألوان. فأنا أرى أن على الفنان أن يقتصد بخطوطه وألوانه. هذا “البخل” دليل عافية، ويحقِّق عنصر الإمتاع للمشاهد، بعكس اللوحة المحتشدة بالألوان والعناصر الكثيرة، التي ترهق العين. الاختزال يحفّز المشاهد أيضاً على مشاركة الفنان في عملية الرسم، بحيث يدفعه من خلال التخيل إلى إكمال اللوحة. وهكذا فالفنان يرسم، ويمحو في الوقت نفسه”.
رحلة الألوان الترابية
من جهة أخرى، عمل الفنان العبدالله بدأب، على إدخال خامة لونيّة جديدة في عالَم الرسم. وأعني بها هنا تلك الرمال الملوّنة، التي سعى بجدٍّ ومثابرة إلى الحصول عليها من الطبيعة، ومعالجتها بأسلوبه الخاص، كي تكون بديلاً عن الألوان المعروفة والمتداولة. وعند التأمل في مزيد من لوحاته، تستوقفنا إحداها بمشهد الطبيعة البكر والتراب الأحمر الذي لم تطأه قدم بعد. فمن أين أتى الفنان بهذه الألوان وبهذا التراب؟
يقول العبدالله: “منذ أيّام الدراسة في جامعة دمشق، كنتُ مشغولاً بموضوع اللون. كنت أبحث عن ألوان خاصّة أرسم بها أعمالي. وفي العام 2006م، وبينما كنتُ أتجوّل في أحد أحياء مدينة دمشق، شاهدت تراباً مدهشاً، فقد سحرني بلونه الأحمر المتوهّج. وفي تلك اللحظة تذكّرت أنني شاهدت قبل ذلك تراباً أبيض أيضاً. وبعد أيّام التقيت بأحد أصدقائي، ولمّا رآني ساهماً في تفكيري، سألني عما يشغلني، فحدثتُه عن ذلك التراب الساحر الذي شاهدته، وقلتُ له: كم أتمنّى أن أعثر على ألوان ترابية أخرى. عند ذلك قال لي: اذهب إلى جبل شيحان وجبل رساس في السّويداء، فذهبت. وحين وصلت وشاهدتُ الجبلين، هالتني ألوان التراب فيهما، وحصلت على ثلاثة عشر لوناً. وبفرح غامر أخذت تلك الألوان وقفلتُ عائداً إلى بيتي في دمشق.
اشتغلت بهذه الألوان التّرابية، ومررت بعدَّة مراحل. في البداية، كانت اللوحة تتكسّر، لكنني صمّمت وقلت لا بد لي من أن أرسم بهذه الألوان، لوحات لا تتعرَّض للتلف. استخدمت الغراء في عملية الرسم، بالإضافة إلى ألوان الأكريليك. كانت تلك التجربة مرهقة، ولكنّها كانت ماتعة أيضاً. وهكذا بقيت أشتغل وأجرّب حتى أنجزت عدداً من اللوحات الناجحة. ولاحقاً استطعت أن أضع ألوان الأكريليك جانباً، وأن أرسم بالألوان الرملية فقط”.
طقوس الرسم
وعند سؤالنا عن المرسم الذي يطبخ فيه أحلامه ويطل منه على العالم، انتقل بنا سعود العبدالله من الصالة عبر ممر إلى حجرة داخلية، ما إن ولجناها حتى كانت المفاجأة: طاولة مزدحمة بعدد كبير من أدوات الرسم، رفوف من الكتب، أوانٍ كبيرة مملوءة بتلك الألوان الرملية التي حدّثنا عنها، عدد من اللوحات الجديدة المنجَزَة حديثاً، والمركونة على الجدار، ثم تلك النافذة التي تطير منها الأفكار، لتحلِّق عالياً في فضاء المدينة، وتعود بعد ذلك بكامل غبطتها لتحط على اللوحة التي يرسمها الفنان. فماذا عن طقوسه الخاصة في الرسم؟
يقول الفنان: “يعنّ على بالي بين فينة وأخرى، أن أذرع الصالة ذهاباً وإياباً، وأنشغل بفكرة ما خفيّة عليّ. ولهذه الغاية أستمع إلى سيمفونية موسيقية. وفي هذه الأثناء، يضطرب رأسي بعدد كبير من الصور، فأجلس، وأتناول القلم وأرسم. لا أعرف ما الذي سأرسمه على وجه التحديد. وهكذا فأنا أرسم عدداً من التخطيطات التي هي نوع من اللعب الفني الجميل. وبعد ذلك أقوم باستقراء الأشكال التي رسمتها، فأختار شكلاً منها يكون أساساً للوحتي الجديدة، التي سرعان ما أقوم برسمها. ومن أجل اصطياد فكرة اللوحة، أحياناً ألجأ إلى العزف على العود، وأحياناً أغنّي”.
العُزلة مملكة الأفكار
“في الرسم أحبّ العُزلة”، يقول الفنّان سعود. ويُكمل “العُزلة تجعلني أتواصل مع ذاتي، وأطل على حشد من الصور التي تتلاطم في أعماقي”.
“العُزلة مهمّة” قلنا للفنان، و”في أجوائها تولد الأفكار التي تسهم إسهاماً فعَّالاً في بناء اللوحة. وبالمقابل، في غياب العُزلة يغيب تركيز الفنان ويتهدَّم التشكيل. يمكن للموسيقى أن تكون عنصراً مساعداً في عملية الرسم، ولكن ماذا عن بعض الخروقات التي تحدث، كأن يباغتكَ صديق ما؟ أو تحضر بعض الكائنات التي رافقتكَ في الطفولة مثل القطط مثلاً؟”.
يجيب الفنان: “في الواقع أنا لا أحتمل أي إزعاج أثناء الرسم. لا أحتمل وجود أحد في المكان، حتى تلك الحيوانات والطيور والقطط التي كنت أحبها في الطفولة. فأنا لا أستطيع أن أرسم وهي تتحرَّك قربي وتتفرج عليّ، فالعين أياً كانت ترهق الإبداع، وتشتِّت الأفكار. الشيء الوحيد عدا الموسيقى الذي أرتاح لسماعه، هو صوت أدوات الرسم. حين أسمع صوتها، يخيّل إليَّ أنني أتحاور معها في شؤون اللوحة. وأنها تتشارك معي في عملية الرسم”.
امرأة الزمن الجميل
ونلاحظ أثناء تأمّل اللوحات أن فيها احتفاءً خاصّاً بالمرأة. نساء كثيرات رسمهن الفنان، كما لو كان يتعبَّد في محراب الجَمَال. فلماذا كلّ هذا الاهتمام بالمرأة؟ وما الذي تمثّله المرأة في أعماله؟
وبشيء من الفرح لسماعه هذا السؤال، هتف سعود: “المرأة من مشاغلي الأساسية في الفن. وهي المولّد عندي لكل ما أرسمه. فدائماً يتصعد لديَّ الإحساس بالجَمَال عندما أرسم المرأة. ولذلك فأنا في الواقع أنتقل من رسم امرأة تحتضن طفلها في إحدى اللوحات، لأرسم امرأة أخرى تقرأ، كما أرسم أيضاً تلك المرأة التي تعمل في الحقل، أو تستلقي في لحظة حلم على الأريكة، وهكذا… وبالمناسبة فأنا لا أرسم حالات المرأة الآن، بقدر ما أرسم حالات المرأة في الزمن الجميل، حيث المرأة المثقفة والمرأة التي تحتفي بالرسائل الورقية، اليوم مضى ذلك الزمن الجميل، ولم يبق للأشياء طعم”.
لا غائـيّة للفن
أجمل ما في لوحات الفنّان سعود العبدالله، هو ذلك الإمتاع العارم الذي يخفق في قلب من يشاهدها. فلعل مهمة الفن قائمة في التخفيف من أثر الكابوس الذي يفتك بالإنسان. نسأل الفنّان: “عدا عن الإمتاع، هل ثمّة مهمّات أخرى تراها للفنّ؟”.
يقول العبدالله: “العمل التشكيلي جميل ببساطته، وبما يحقِّقه من فرح وأمل لدى المشاهد، أما أن يتم إثقاله بمزيد من القضايا السياسية والاجتماعية، فهذا مما يضعف العمل، ويجعل من الفنان محض تابعٍ للآخرين. اللوحة طوال عمرها لم تقوَ على حلّ مشكلة، حتى “الجرنيكا” التي رسمها بيكاسو أيّام الحرب الأهلية الإسبانية، فهو لم يرسمها من أجل حل ما، بقدر ما رسمها لتكون شاهداً فنياً على عمليات القصف والإبادة التي تعرَّضت لها هذه المدينة، لذلك كلّه فأنا لا أؤمن بغائية الفن.
هناك فنانون عرب مولعون برسم الموت. ويرسمون القتلى والدّم بأكاديمية عالية. ولكن هل الفنان مجبر على رسم الموت؟ في رأيي هذا نوع من التشوه الدّاخلي. على العكس من ذلك، الفنان مطالب برسم الجمال، ومطالب بطرح النقيض”.
ضد الهويات الضيّقة في الفن
ثمّة مشكلة يمكن أن يواجهها الفنّان العربي، وتتمثّل في تصنيفه في مدرسة فنية ما، أو في تيار فني. ومثل هذا الوضع ربما يُعَد قيداً على الفنان، فيحد من حريته، ورغبته العارمة في تحطيم الأطر ومعانقة العالم. يقول الفنان سعود في هذا الصّدد: “أنا ضد الهويّة في الفن، وضد هذه التقسيمات: الواقعي، والسوريالي، والوحشي،…إلخ. وأنا مع حريّة الفنان ليرسم ما يريد. أنا مع مفهوم الحداثة ببعدها الشامل”.
ويضيف: “أنا ضدّ التقليد الفج. يحزنني هذا التهافت باتجاه التعلُّق بأردان الفن الغربي، رغم عظمة هذا الفن. تحزنني أيضاً تلك الكتابات التي تحيل كل شيء إلى الغرب. نحن أيضاً كفنانين عرب لدينا إسهاماتنا المتميزة. في مصر مثلاً لدينا محمود سعيد، عبدالهادي الجزّار، سوسن عامر، حلمي التوني، تحية حليم. وفي المغرب لدينا أحمد الشّرقاوي، فريد بلكاهية. في لبنان لدينا أسماء مهمّة جدّاً..لذلك كله، أنا لا أؤمن بوضع الفن في خانة محدَّدة (محلية، قومية، شرقية، أو غربية). هناك فقط فن ينتمي إلى الجَمَال”.
الذاكرة حافلة بما يُحب
ويختتم الفنَّان حديثه إلينا بكلمة معبّرة عما للذكريات من مكانة في نفسه. فيقول “الأشكال في أعمالي هي ومضات من ذاكرة قديمة. كان فضول الطّفولة يتحوَّل إلى تأمل طويل، إلى صور وأختام في الذاكرة. أنا لا أرسم الواقع الحالي، لأنه يحرمني الحنين. حين أرسم، أقلِّب صفحات الذاكرة الندية، وبحنين وشغف، وببعض الدموع والشّوق أقلّب تلك الصفحات، فأرى فيها: طفولتي، وجه جدتي، جارنا الستيني الطيب الذي يعشق الجلوس في ظل جدار بيته عصراً، نساء قريتنا المسنات بلباسهن الملون بألوان غامقة في الغالب وهن جالسات على شكل دائرة غير مغلقة.
في تلك الصفحات أرى أكوام حطب القطن، وأكوام قش الحِنطة والشعير! أرى القطط التي كنت ألعب معها أكثر من اللعب مع أقراني.
كل هذه الأشكال تتكوَّن فوق صفحات دفاتري لا إرادياً ولكن بحُب وابتسامة، وحزن قديم.
الساعات المتأخرة بعد الواحدة ليلاً هي ساعات إلهامي، حيث تتمدّد الذكريات، على بساط ورقي، مُشكِّلَةً وِلادات جديدة”.
**نبذة عن سيرة الفنان
سعود العبدالله فنان سوري، ولد في مدينة الحسكة في العام 1976م. درس الفن التشكيلي في كلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة دمشق، وتخرَّج فيها عام 2005م. حصل على دبلوم الدراسات العليا في العام 2006م.. درّس مادة الرسم لمدَّة ست سنوات، ما بين عامي 2007 و2012م. تنقَّل في الإقامة ما بين الحسكة، ودمشق، وبيروت، ودبي والأردن.
أقام الفنان عدداً من المعارض الفردية، كما شارك في عدد من المعارض الجماعية، ومنها:
1.معرض “Art fair”، القاهرة، 2020م.
2. معرض “Rizing Art Expo”، بيروت، 2019م.
3. المعرض الجماعي الصّيفي في جاليري “Art on56th”، بيروت، 2019م.
4. معرض “سكّة دبي”، 2019م.
5. معرض جماعي في “Hub Gallery”، تحت عنوان “إلغاء المادة 153″، مدينة الكويت، 2018م.
6. معرض فردي بعنوان “امرأة تتحدّى الانتظار”، في جاليري “Art on56th”، بيروت، 2017 – 2018م.
7. معرض جماعي بعنوان “نساء في الحرب” في “Hub Gallery”، مدينة الكويت، 2017م.
8. معرض “Art fair”، بيروت، 2015م.
9. معرض جماعي “أوليمبيا لندن”، لندن، 2015م.
10. معرض فردي “فن 56″، بيروت، 2014م.
11. معرض “Art fair”، بيروت، 2014م.
12. المعرض الجماعي الصّيفي في جاليري “Art on56th”، بيروت، 2014م.
13. معرض في “جاليري بلاتينيوم”، بيروت، 2012م .
14. معرض “Art fair”، بيروت، 2012م.
15. معرض جماعي للفن في مدينة “ريجيو إميليا”، إيطاليا، 2012م.
16. معرض “مسابقة شغف” في “Kamel gallery”، دمشق، 2011م.
17. “معرض أساتذة كلية الفنون الجميلة” في معرض دمشق الدولي، دمشق، 2007م.
18. “معرض الشّباب”، دمشق، 2004 – 2005م.
**حقوق النشر محفوظة لمجلة القافلة، أرامكو السعودية