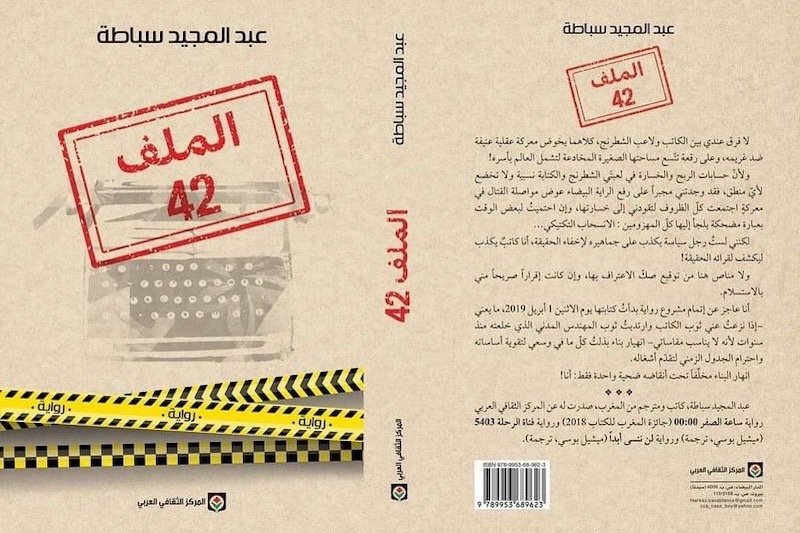شكك كثير من رواد نظريات المؤامرة في حجم الإصابات والوفيات بمرض “كوفيد-19″، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (سارس كوف 2)، واعتبروا أن الأعداد الواردة في هذا الخصوص مبالغ فيها، وتجانب الواقع، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خدعة لتسهيل اعتماد سياسات تحكمية لا تخلو من مخاطر مستقبلية.
ويرى الكاتب إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، في مقال له عن “محك الجائحة ومتاهات المؤامرة”، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، “بل قام كثير من الأشخاص الذين انطلت عليهم هذه النظريات بالتنديد بالحجر، معتبرين أنه ينطوي على تدابير سياسية تقيّد الحقوق والحريات أكثر منها تدابير احترازية صحية تدعم أمن وسلامة المجتمع. فيما اتجه آخرون إلى التظاهر في عدد من البلدان الأوروبية، وهو ما حدث في بريطانيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا والسويد والدانمارك… وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كتعبير عن رفض التدابير المتخذة للبدء في عمليات التلقيح الجماعي”.
ويحاول الكاتب في مقاله هذا أن يوضح كيف تمكن العلم من إحباط ما يعرف بـ”نظرية المؤامرة” وما يحيط بها.
وهذا نص المقال:
تفرض الأزمات والكوارث ظروفا استثنائية وضاغطة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والنفسية، وتشير الكثير من الدراسات التاريخية إلى أن هذه المحطات الصعبة غالبا ما يرافقها انتشار الأفكار الخرافية ونظريات المؤامرة، التي يلجأ إليها الإنسان كسبيل للتخلص من القلق، والأسئلة الصادمة، وهو ما يحدث عادة عند وقوع الأوبئة والمجاعات والكوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات… أو الأزمات الدولية الخطيرة.
ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت الأخبار الزائفة والإشاعات في الانتشار بسرعة كبيرة، ساهمت فيها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية. ومع تطور حدّة الوباء من حيث تزايد نسبة الإصابات والوفيات، وما صاحب ذلك من اعتماد تدابير صارمة، على مستوى فرض الحجر الصحي وتقييد حركة التنقل وإغلاق المطارات، والمدارس والمطاعم والفنادق… تصاعدت نظريات المؤامرة وتمدّدت كالنار في الهشيم محدثة ردود فعل مختلفة؛ فالأمر يتعلق بحسب رواد هذه النظريات بمؤامرة كونية كبرى، يقوم فيها أطراف بتوجيه الأحداث والقضايا الدولية من خلف ستار.
بينما زعم البعض أن فيروس كورونا غير موجود أصلا، أو إنه ليس قاتلا، وهو ما حدا بعدد من الأشخاص في مختلف بلدان العالم ممن اقتنعوا بهذه التوجهات إلى رفض استعمال الكمامات أو الانضباط لمتطلبات الحجر الصحي، فيما زعمت بعض الجماعات كـ”كيو أنون” الأمريكية أن “الهدف من الترويج لمخاطر الفيروس هو التغطية فقط على الاتجار بالجنس مع الأطفال”، وادعت أن هناك “دولة عميقة” داخل الولايات المتحدة تتحكم في مسار العالم، وتسعى إلى توظيف تكنولوجيا الجيل الخامس للأنترنت في هذا الصدد.
وفي خضم هذه التطورات، اعتبر البعض أن الأمر يتعلق بأزمة مفتعلة، يتم من خلالها التعتيم وتصريف أزمات حقيقية بعيدا عن الأضواء، وإثارة الخوف والفزع داخل المجتمعات، بصورة تسمح بتيسير تمرير قرارات وتشريعات يصعب أو يستحيل تمريرها في الحالات العادية محليا أو دوليا. وشدد البعض الآخر على أن الأمر يتعلق بحروب بيولوجية مستحدثة لتحقيق المصالح وتصفية الحسابات، ضدّا على كل المعاهدات والقانون الدوليين، فيما تحدّث آخرون عن تجارة جديدة تقوم على المتاجرة في آلام الناس بخلق الفيروس لبيع لقاحاته.
شكّك كثير من رواد هذه النظريات في حجم الإصابات والوفيات، واعتبروا أن الأعداد الواردة في هذا الخصوص مبالغ فيها، وتجانب الواقع، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خدعة لتسهيل اعتماد سياسات تحكّمية لا تخلو من مخاطر مستقبلية. ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل قام كثير من الأشخاص الذين انطلت عليهم هذه النظريات بالتنديد بالحجر، معتبرين أنه ينطوي على تدابير سياسية تقيّد الحقوق والحريات أكثر منها تدابير احترازية صحية تدعم أمن وسلامة المجتمع، فيما اتجه آخرون إلى التظاهر في عدد من البلدان الأوروبية، وهو ما حدث في بريطانيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا والسويد والدانمارك… وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كتعبير عن رفض التدابير المتخذة للبدء في عمليات التلقيح الجماعي.

ويبدو أن الوباء وما يمثله من ضغط كبير على نفسية الأفراد، ساعد على التفاعل بشكل إيجابي مع هذه النظريات وما رافقها من إطلاق إشاعات وأخبار كاذبة ومضلّلة، اعتبر كثير من الباحثين والمهتمين أنها لا تقل خطورة عن الوباء في حد ذاته، من حيث إثارة الرعب والهلع والخوف من المستقبل، وإرباك الجهود المبذولة في سبيل تطويق الأزمات والكوارث.
تبنى بعض زعماء الدول أيضا هذه النظريات بشكل أو بآخر؛ فالرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” ظلّ يردّد أن الأمر يتعلق بـ”فيروس صيني”، كما أنه كان يهوّن من خطورة الوباء، ما عرّضه لكثير من النقد من قبل خصومه السياسيين الذين اتهموه بالاستهتار بأرواح الأمريكيين، وهو ما ذهب إليه أيضا وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيدو” بتأكيده أن الفيروس صنع داخل مختبر صيني كسبيل لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتجارية الضيقة، فيما ردّت بعض الأطراف داخل الحكومة الصينية على ذلك باتهامات تحيل إلى أن الجيش الأمريكي هو من أتى بالوباء إلى منطقة “ووهان”. كما أن الرئيس البرازيلي “غايير بولسونارو” أصدر مجموعة من التصريحات “الغريبة” قلّل فيها من خطورة الفيروس، وذهب إلى حد التحذير من “التداعيات الخطيرة” للقاحات المطروحة.
وعندما تم الإعلان عن إصابة الرئيس “ترامب” بالفيروس، انتعشت من جديد نظريات المؤامرة بشكل قوي، حيث اعتبر البعض الأمر مجرد “خدعة” لحصد التعاطف الانتخابي، ولكسب المزيد من الأصوات في مواجهة خصمه “جو بايدن”، فيما ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك، باعتبار الإصابة مجرد إشاعة تمهّد لتجريب نجاعة لقاح أو دواء أمريكي، في أفق ترويجه على الصعيد العالمي.
تعرضت منظمة الصحة العالمية أيضا لهذه الإشاعات بعد اتهامها بالتورط في تفشي الوباء خدمة لأجندات ومصالح بعض الدول الكبرى، ولم يسلم الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “مايكروسوفت” “بيل غيتس” بدوره من الاتهامات والإشاعات في هذا الشأن، بعدما تحدثت بعض الأوساط عن تورطه في السعي لوضع شريحة تحت جلد الأفراد بغية التحكم فيهم من خلال تكنولوجيا الجيل الخامس للأنترنت، في أفق التخلّص من حوالي 15 بالمائة من ساكنة العالم، عبر صناعة اللقاحات التي يشرف على تمويلها في مناطق مختلفة من العالم.
يوما بعد يوما، يؤكد العلم والواقع والمحطات التاريخية المماثلة هشاشة نظريات المؤامرة؛ فقد حسم العلماء في المنشأ الطبيعي للفيروس، ورحل “ترامب” عن البيت الأبيض بسبب عوامل عدة، من بينها سوء تدبيره للجائحة، وفي الوقت الذي يصرّ فيه البعض على أن القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية تظل مسؤولة عن المؤامرة، وتسعى إلى الاستفادة منها استراتيجيا واقتصاديا، تبرز التقارير العلمية والمعطيات الإحصائية أن هذه الدولة، كما عدد من الدول الكبرى كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، تقع على رأس الدول الأكثر تضررا من الوباء، سواء على مستوى عدد الإصابات والوفيات، أو على مستوى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.